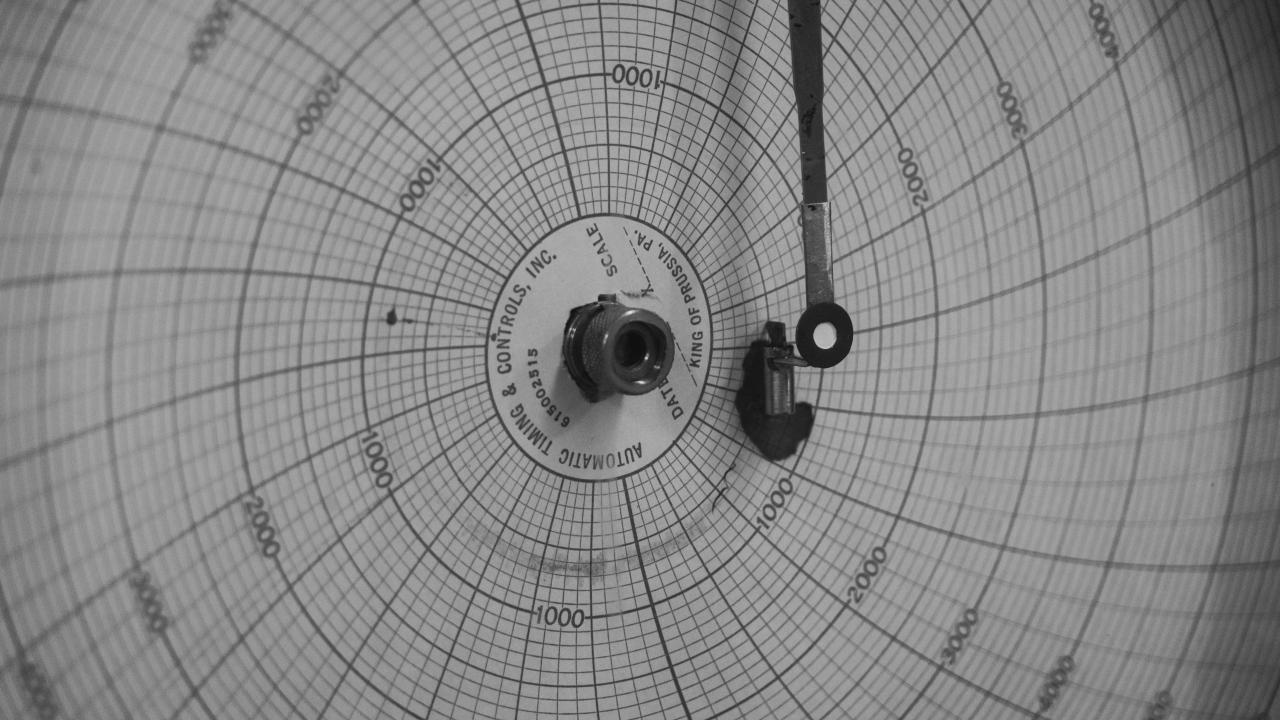القصص
كل قصة منشورة هنا تستند على معلومات أخبرتنا بها عائلات المفقودين، وتسرد لنا من هو الشخص المفقود وتنتهي بهذا الطلب: "لا تدع قصتي تنتهي هنا". وهذا المطلب هو دعوة للمواطنين إلى اتخاذ خطوة للخروج من فقدان الذاكرة الجماعية والوقوف وراء الحق في معرفة مصير ومكان وجود المفقودين.
جورج أبي نَكد

جورج أبي نَكد
إسـمي جـورج. كنـت أعشـق كـرة القـدم كمعظـم الشـباب فـي سـنِي. كانـت أختـي دائمـا تقـول لأصدقائـي ممازحة: "إذا كنتـم تبحثـون عـن جورج ولـم تجـدوه، فاذهبوا ً إلـى ملعـب كـرة القـدم، هنـاك حتما سـتلاقونه". كـم أتمنى لـو كان ذلـك صحيحـا َ الان... بعـد أن تخرجـت مـن الثانويـة ،كنـت أنتظـر فرصتـي للالتحاق بالكلية الحربية. فــي تلــك الأثناء، كنت منشغلا بالاعتناء بوالدتي التــي كانــت مريضة حينِهــا، كمـا كنـت أسـاعد والـدي فـي عملـه.
فــي 19 تمــوز مــن العــام 1983 ، وبينمــا كنــت أقــود شاحنة البيك-أب متّجهــا مــن زحلـة إلـى بيـروت، فـي مـكان مـا علـى الطريـق، اختَفْيت. شـاء القـدر أن يكـون ذلـك اليـوم هـو اليـوم الوحيـد الـذي صـودِف فيـه عـدم مرافقـة والـدي لـي للعمـل، إذ كان مريضا و أجبـر علـى البقـاء فـي المنـزل.
بعـد أن فقِـدت، أصبـح أبـي يلـوم نفسـه دائمـا لعـدم وجـوده معـي فـي ذلـك اليـوم. كمـا أنـه قـام بـكل مـا بوسعه لإيجـادي، فباع أرضه المزروعة و تراكتـوره لكـي يتمكن أن يدفـع المـال إلـى أشـخاص لقـاء معرفة مـا الـذي حـل ّ معـي، لكـن كان كل ذلـك مـن دون نتيجــة. أمي لــم تــفــقــد الأمــل يومــا، وكانــت دائمــا بانتظار عودتي إلــى البيــت يومـا مـا. بقيـت تنتظرني حتـى آخر نَفـسٍ لهـا. كانت دائمـا ً توصي أخوتي قائلة لهم: ”اذا متت قبل ما يجي جورج، بس يجي اطرقولي طرقتين على القبر“. إذا لم أستطع أن أعود حيا، أودّ أن أُدفن بسلام قربها.
اسمي جورج أبي نَكد. لا تدعوا قصّتي تنتهي هنا.
شربل زغيب

شربل زغيب
إسـمي شربل. كنـت متزوجـا مـن لـور لمدة إحدى عشر عامـا. كنـت أدعوها ”شـيخـه“. أنـا و لـور لدينـا طفلان رائعان: رامـز، ابـن الأعوام الستة، كان يحـب أن يفعل كل شـيء تمامـا مثلمـا أفعلـه ُ أنـا، و ربـى، بنت الخمسـة أعـوام، أميرتي الصغيرة.
كنــت أعمــل بجــد كســائق أُجــرة. فــي كل يــوم وبعــد الانتهــاء مــن العمــل، كنــت ُ ”اخشـخش“ النقـود المعدنيـة فـي جيبـي وأنـا أصعـد علـى درج منزلنا. كان رامز وربى يعرفان أن والدهمـا قـد وصل إلى المنزل من صوت خشخشة النقود، و كانا يركضان نحــو البــاب لإســتقبالي بالعناق. كنــت فعـلا رجلا محظوظا. فــي الثالــث مــن تشــرين الأول عــام 1983 ،غــادرت منزلــي فــي الصبــاح، كعادتــي، للذهــاب إلــى العمــل. أخــذت راكبا ُ إلــى المطــار. وبينمــا كنــت عائدا،ً أوقَفنــي حاجـز وطلب مني النزول مــن السـيارة.
لم أعد إلى منزلي مجددا. رامز وربى لم يسمعا والدهما يصعد الدرج مجددا.
أخـذ الأمـر مـن زوجتـي لـور سـنين عـدة كـي تستطيع أن تخبرهمـا أننـي قـد فقـدت. وكيـف لهـا أن تفسّـر ذلـك؟ كيـف لهـا أن تجيب عن أسئلتهما ؟ كانت تقول لهما أنني مسافر وأني مشتاق إليهما وأحبهمـا كثيـرا . بـدأت لـور تـزاول عمليـن كسـكرتيرة كـي تسـتطيع أن تؤمن لو لدينـا حيـاة كريمـة وتضمن بقاءهمـا فـي المدرسـة. هنـا، أيضـا، كانـت بدايـة معاناتهـا الطويلـة والأليمـة فـي البحـث عنـي. خـلال أشـهر عـدة، حاولـت التواصـل مـع العديـد مـن رجـال السياسـة لمعرفـة مـكان اعتقالـي وإمكانيـة عودتي إلى منزلنا مجددا َ . لكنهـا لـم تحصـل علـى أيـة إجابـة قـطّ.
بقـي الأمـر علـى حالِـهِ حتـى اليـوم الـذي اتصـل بهـا رجل أُفرج عنه من سوريا وقال لها أنه كان معتقلا معـي. هـذا الرجـل كان قـد سمع لـور وهـي تخبـر قصـة اختفائـي علـى برنامــج ”كالم النــاس“ وكان قــد تعـرّف علــى قصتـي. كــم كان ارتياحها كبيــرا. فأنــا مـا زلـت حيًـا. أعطاها ذلـك الأمـل بأننـي سـوف ُ أعـود ً يومـا إلـى البيـت. لكـن مـع مـرور الوقـت، بـدأ اليـأس يتزايـد. لا زالـت لـور تسـأل و لكـن دون أن تعثر علـى أجوبـةٍ شـافية. إسمي شربل زغيب. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
سعيد خباز

سعيد خباز
إسـمي سـعيد وكنـت فـي السـابعة عشـرة مـن عمـري، حينمـا طُلـب منـي أن أترجـل مـن سـيارة الأجـرة. حصـل ذلـك فـي الثانـي عشـر مـن آذار عـام 1985 .كنت قـد تركت منزلـي فـي زغرتا، وتوجهـت الـى بيـروت. لـم أكـن لأعـرف وقتهـا، أننـي لـن أرى منزلي مجددا.
لـم أكــن ملتحقا بالمدرســة. توفــي والــدي وكنــت أبحــث عــن عمــل لاعالــة والدتــي وشــقيقي ّ . لــم تكــن لــدي مشــكلة فــي مساعدتهم، فقــد كنــت أعمــل فــي فصــل الصيــف علــى أي حــال، وكنــت أُسرُّ بالاعمــال المنزليــة. يقولــون إني كنــت ناضجا بالنسبة إلـى عمـري. اقتضت خطتي أن أنخرط فـي الجيـش. كنـت أحـب زيـارة أختــي الكبيــرة، لينــا، المتزوجــة. كانــت تســكن فــي عمشيت التــي كانــت منطقــة معروفة ً بهدوئها وكنـت أحـب الذهاب إلـى هنـاك هربا ً مـن توتـر الحـرب. كنا نخرج معا ونزور ُ الأصدقــاء. كانــت تجمعنـا علاقــة مميــزة وكنــت أخبرها عــن الفتــاة التــي تعجبنــي. أمضــت عائلتــي قــدرا ً كبيــرا ً مــن الوقــت تبحــث عنـي. بعــد التحقيــق مطولا، عثــرت عائلتــي علــى شــخصين ادعيــا أنهمــا رأيانــي فــي مركــز اعتقال فــي ســوريا.
أحيانا تجد عائلتي صعوبة في التكلم عني، لكنهم لا يزالون يأملون في معرفة ما حدث لي.
إسمي سعيد خباز. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
عماد عبدالله

عماد عبدالله
إسـمي عمــاد. أنــا آخــر العنقــود مــن بيــن 5 أولاد. كنــت ُ مقربا جــدًا مــن أختــي الكبرى سـامية، فهـي عَمليًـا مـن ربانـي. كنـت أبلغ مـن العمر 9 سـنوات عندمـا تزوجت سـامية وانتَقَلـت إلـى بيتِهـا الجديـد. كنـت أذهب لزيارتها يوميًـا بعـد المدرسـة. وفـي العطـل الأسبوعية، كنا نأخذ ابنهـا ونذهب معا إلى شاطئ البحـر. كان شقيقاي يمازحانني ويهـزآن بـي لأننـي كنت مـن النوع الهادئ والرومانسي. كنت ُ أمتلك مذكرة أكتـب فيها قصائدي ورسـائل الحـب. كنـت أيضـا أهـوى مشـاهدة أفـلام عـادل إمـام القديمـة، فكنت أشاهدها مِ مرارا ً وتكرارا دون ملل أو كلل، وخاصة أفلام الكوميديا الرومانسـية. فـي الوقـت الـذي وقـع فيـه ذلـك اليـوم المأسـوي، كنت علـى وشـك عقـد خطوبتي. كانــت تدعى سميرة. كنــت قــد ادخــرت مــا يكفــي مــن المــال كــي أشــتري لهــا خاتــم الخطوبـة مـن متجـر المجوهرات حيـث كان زوج أختي يعمـل. كنت في قمة الحماس. ولكـن مخططـي لحيـاةٍ جديـدة مـع الفتـاة التـي أحببـت قطِع فـي عـام 1984.
كنت في ذلك اليوم مع اثنين من أصدقائي، محمد ودرغام.
كنا نشقّ طريقنا قادمين من حفل زفاف في طرابلس ومتوجهين نحو بيروت عندما أوقفنا حاجز على الطريق. درغام قتل على الفور، وأخذنا أنا ومحمد بعيدا.
خطر لعائلتي أنه مـن الممكـن أن أكـون قـد أُخـذت إلـى سـوريا، فسافروا إلـى هنالِك متأمليـن إيجـادي فـي أحـد السـجون السـورية. جميـع الأشـخاص الذين إلتقوهم نفوا وجودي فـي أي معتقل. رغـم ذلـك، لـم تفقـد أختــي سـامية الأمـل قـط بأننـي سـوف أعــود إلــى المنــزل يومـا ما. مرت الســنين وانتهــت الحــرب ولكنني لــم أرجــع وهنــاك الآلاف مثلـي.
مـع نهايـة التسعينيات، افـرج عن أشخاصا قالوا لأختـي إنهـم قد رأوني في المعتقل. يمكنكـم أن تتخيلوا الكـم الهائل مـن السـعادة والإرتيـاح الذيـن شعـرت بهما عائلتي حينها. وفـي عـام 2003، وبعـد أن زار شـخص مـن صيـدا أخاه في سـجن سـوري ، أحضر رسـالة إلـى أختي مكتوبة بخط يدي. أصبح الأمر مؤكدا أنني علـى قيد الحياة، وسـوف أعود إلى بيتي وعائلتي. تلت هـذه الرسـالة رسـالة ثانيـة، و كانـت الأخيـرة. عندمـا بـدأت الحـرب فـي سـوريا، أملت عائلتـي أن يطلق سراحي، ولكن آمالهم وطموحاتهم تبعثرت وانهارت، تماما مثلما انهارت آمـال المئات من العائلات الأخرى.
هــم لا يعرفــون أيـن أنـا أو حتى إذا مــا كنت لا أزال علــى قيـدِ الحياة. ولكــن، وعلــى الرغـمِ مـن مـرور 32 عاما، هـم لا زالوا يؤمنون بأننـي قـد أعـود. قـد تظنـون أن هـذا مـن الحماقـة. ولكن، منذ بضعة سنوات، عاد شـخص مـن سـوريا كان معتقـلا فـي سـجونها لأكثـر مـن 30 عامـا. كيـف لأحـد أن يكـفّ عـن الأمـل عندمـا يكـون هناك ولـو أصغــر إمكانية؟
إسمي عماد عبدالله. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
علي مصطفى

علي مصطفى
إسـمي علـي. عندمـا اندلعـت الحـرب، كنـت أعمـل فـي مرفـأ بيـروت. فـي أحـد الأيـام، وبينما كنـت أعمــل، سـمعت طلقـات رصـاصٍ وصراخ ثـم رأيــت أناس يركضون. ســرعان مــا فهمــت مــا الــذي يحــدث. فلــم يكــن لــدي خيــار إلا الفرار لإنقاذ نفســي. وجـد البعـض مـن عمـال المرفـأ مـأوى لهـم فـي مكاتـب زمالئهـم الذيـن لـم يكونـوا ً مستهدفين، نظرا لانتمائهم الديني. أمـا أنـا فقـد قـررت الفـرار عـن طريـق البحـر مـع آخرين مثلـي.
ولكن كان قد فات الأوان، إذ لم يكن لدي الوقت الكافي للهرب.
كل ذلــك حصــل فــي 6 كانــون الأول عــام 1975 ،أثنــاء اليــوم المشؤوم المعــروف بإسـم ”السـبت الأسـود“.كنت فـي الخامسـة والعشـرين مـن عمـري، وكان ابنـي لا يتخطـى الشهرين مـن عمـره. لـم تسـتطع زوجتـي الـزواج مجـددا، إذ كانـت سـتضطر إلـى إعـلان وفاتـي ولـم يتمكـن أقربائـي مـن فعـل ذلـك، لأنهـم شـعروا بـأن هـذا يعنـي التخلّي عني.
أنـا واحـد مـن مئـاتِ الضحايـا المجهولـي الهويـةِ الذيـن ماتوا فـي ذلـك اليـوم، والذين ترفض أسـرهم التخلــي عــن حقهـم فــي معرفــةِ مصيرهــم. ”ُألقــوا فــي البحــر“ أو“نقلــوا إلــى منطقــة أخــرى فــي بيــروت لدفنهم“ هــي الإجابات الوحيــدة التــي وصلتهم حتــى اليــوم.
إسمي علي مصطفى. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
أحمد هرباوي

أحمد هرباوي
إسـمي أحمـد كنـت الإبـن الاكبـر فـي عائلتـي، وأخـذت هـذا الـدور علـى محمـل الجـد. بعـد وفـاة والـدي، أصبحـت ُ أنـا المعيـل لأمي وأخوتـي السـتة. كنـت شـخصا مسـؤولا، ولكنـي فـي الوقت نفسـه كنـت أقوم بأعمال شغب مع أخوتي. كنا نتسلل من البيت ونذهـب إلـى سـاحة الشـهداء حيـث كنـا نجتمع مـع أصدقائنا. غالبا مـا كان ذلك يسـبب لنـا الكثيـر مـن المتاعـب مـع والدتنا. وأنـا مـن كنـت دومـا أتَلّقـى اللـوم بـدلا منهـم.
مـع بدايـة الحـرب، كنـت على وشـكِ فتـح متجر كـي أساعد عائلتي و كـي استقر ّ وأكون عائلـة لنفسـي. ولكـن مخططـي لـم يكتمـل. حيـن كانـت الحـرب لا تـزال فـي أشـهرها الاولـى ومع اشتداد الاشتباكات، قررنا أن نترك منطقـة النبعـة حيـث كنـا نعيـش مـع جدتـي ونستقر فـي ناحيـة بيـروت الغربيـة.
ذات يـومٍ ، وبينمـا كنـت راكِبـا سيارة أجرة، برفقة أمي وأختي متجهين إلى بيتِنـا الجديد بعـد زيـارة جدتـي، أوقفنا حاجز علـى الطريق. طلب منـي التَرجل من السـيارة، وكذلك طلـب مـن راكبين آخريـن – تاركين أمـي وأختي في سـيارة الأجرة.
أمي خديجة صاحت وصرخت توسّلا للرجال المسلحين كي يدعوني وشأني. لكنهم لم يفعلوا ذلك.
كالعديــد مــن عائلات الأشــخاص المفقودين، تلقت أمــي مكالمــات مــن أشــخاص وعدوها بـأن تكلمنـي عبـر الهاتـف مقابـل مبلـغ مـن المـال. فـي كل مـرةٍ ، كانـت تدفـع المــال المطلـوب. وفــي كل مــرةٍ ، كانــت تأمــل أن تكــون هــذه المــرة مختلِفــة عــن سابقتها، وأنه ّ بإمكانها أن تثــق بهــذا الشــخص. لكنهــا لــم تتكلـــم معــي قــط. لقــد استفاد هـؤلاء الأشـخـاص مـن وضعِهـا، واستغلوا يأسـها. أصبحـت أمـي محطمـة، وأثّــر ً ذلــك كثيــرا ّ علــى صحتِهــا.
منـذ ذلـك الحيـن، وهـي لـم تتوقـف عـن البحث عنـي. خلال ذلـك، تَعَّرَفـت علـى أهالي يعانـون مـن ألـم المأسـاة نفسـهما، فبدأوا يطالبون معـا بالإفراج عـن أحبائهـم. حتى هـذا اليـوم، حضـرت أمـي جميـع التظاهرات والاجتماعات، مطالبة الحصـول علـى أجوبـة. لكـن منـذ أيـامٍ قليلـةٍ ، فـي يـومِ عيـد الأم، توفيـت أمـي. مثـل أوديـت ونايفـة والعديــدِ مــن الأمهــاتِ الأخريــات، ماتــت أمـي مــن دون أن تعــرف مــا الــذي جــرى مــع ابنِهـا. لكن نضالهن لم ينته. إسمي أحمد هرباوي. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
وجيه زحلان

وجيه زحلان
إسمي وجيه زحلان وعن عمر الثامنة والثلاثين، كنتُ متزوجاً ولديّ أربعة أولاد، أقطن في عاليه وأدير مجموعة من العمّال. كانت الحرب قد بدأت ولكنني كنت عازماً على متابعة حياتي وتفادي الحرب. لم أكن منضماً لأي من الأحزاب أو منضوٍ تحت أي تحرّك. ما كان يهمّني، عملي وعائلتي. كنتُ رجلاً صلباً وأحببت العمل بيديّ. إبني، أيمن، والذي كان صغيراً آنذاك يتذكر رؤيتي أكسر حجراً من الاسمنت بيديّ المجرّدتين. كنتُ أحبّ قضاء السهرات مع أصدقائي وعائلتي، وعادة ما كنا نجتمع في منزلنا لأخذ دروس موسيقية. أحببت الغناء، والحياة كانت جيدة، حقاً. وبعد ذلك، توقفت الحياة. ففي الثاني عشر من آب للعام 1982، كنت متوجهاً الى البقاع لعمل الصيانة. تركت منزلي في الخامسة فجراً، عندما كان الكلّ نيام. كان من المفترض أن أتصل بزوجتي حالما أصل الى البقاع ولكنني لم أفعل ذلك مطلقاً.
وُجدت سيارتي لاحقاً في مكان ليس بالبعيد عن منزلي، بالقرب من بلدة بحمدون.
لا يزال أولادي يتساءلون عما حدث لي.
لا تدعوا قصتي تنتهي هنا !
قزحيّا شهوان

قزحيّا شهوان
إسمي قزحيّا شهوان. وُلِدتُ في كانون الاول من العام 1951 في شمال لبنان. عِشتُ في مدينة البترون وقمت مع زوجتي بتربية عائلة من 4 أطفال وقضينا حياة هادئة. كنت أعمل في شركة المواد الكيماوية صلعاتا وبعدها أعود مباشرة الى المنزل لمساعدة زوجتي في تربية الاولاد، فكنتُ أساعدهم على الاستحمام، أطعمهم وأقضي وقتي معهم. لديّ صبي واحد وثلاثة بنات. وقتذاك، ميشلين، ابنتي ذات السنتين، كانت لا تغفو إلا بين ذراعيّ.
نجحنا في توفير بعض المال وشراء قطعة أرض. بدأنا ببناء أسس منزلنا الجديد على قطعة الأرض، وكانت الفرحة لا تسعني أنا وزوجتي عندما كنا نزور أرضنا. على قدر ما كنتُ أفرح بعائلتي وأصدقائي، كنت أفرح بوحدتي.
إنّها نعمة كبيرة أن تسكن بالقرب من البحر، فقد أحببتُ صوت تلاطم الأمواج على الشاطئ ورؤية المياه تتلألأ تحت أشعّة الشمس.
كنتُ في العمل حينما تلقيت مكالمة من المخابرات السورية، ولقد تمكّنت زوجتي من زيارتي في سجن دمشق وبعدها، لم ترد أيّ أخبار جديدة.
لا تدعوا قصتي تنتهي هنا !
احمد فيصل ديراوي

احمد فيصل ديراوي
إسمي احمد فيصل ديراوي وكنتُ في الثالثة عشر من عمري حينما إفتُقدت في السابع عشر من ايلول للعام 1982 في الأحداث التي باتت تُعرف اليوم بمجزرة صبرا وشاتيلا. قبل ذلك اليوم، كنتُ واحداً من أفضل تلامذة صفّي، أحببتُ المدرسة. كنتُ معجباً بكتابة وحفظ دروس المدرسة كالشعر والأسماء والتواريخ المذكورة في مادة التاريخ.
كنتُ أخرج قليلاً مع أصدقائي بالرغم من أنّني كنت أفرح حينما أبقى وحدي. كنت أمي تقول لي دائماً أنّني سأصبح ذو طول فارع حينما أغدو شاباً علماً أنّني كنت لا أزال أخاف من الظلمة وأنا في عمر الثالثة عشر.
حينما افتُقِدت، كان أقسى ما فكّرت به امّي، أن أكون محتجزاً في الظلمة في مكان ما. كانت تعرف مخاوفي. مخاوف ولد في الثالثة عشر من عمره.
لا تدعوا قصتي تنتهي هنا !
كاريمان أحمد

كاريمان أحمد
إسمي كاريمان أحمد. وُلِدتُ في الثالث والعشرين من كانون الثاني للعام 1956. لم أكن قد بلغتُ العشرون من العمر عندما إندلعت الحرب في موطني، غير أنّني كنتُ كبيرة بشكل كافٍ لأختبرها وجهاً لوجه. عملتُ كممرّضة وقضيتُ أياماً وليالٍ طوال أعمل على الصعيد الإنساني والإجتماعي. وفي ذلك الوقت، تزوّجتُ وأمسيتُ أمّاً فخورة لرشا وزياد. وعلى هذا المنوال، مضت الحياة أثناء الحرب.
عائلتي كبيرة فأهلي أنجبوا ثمانية أولاد. اليوم، واحدٌ من أخوتي فقط بقي في لبنان، وأمّا الآخرون فواحدٌ قد قُتِل والبقيّة هاجروا. وفي نهاية المطاف، بقيتُ أنا، لا أحد يعلم ما حدث لي منذ ذلك اليوم في حزيران 1986.
كنتُ على الطريق إلى منزلي بُعيدَ زيارتي لأهلي، ومتلهّفة لإحتضان ولديّ بين ذراعيّ ! في مكان ما، بين بيروت وصيدا، خُطِفت ! كانت الحرب مستعرة منذ 10 سنوات، وبالرغم من أنّني كنتُ شغوفة بمساعدة مجتمعي، كانت أمنيتي أن آخذ ولديّ للاستقرار في مكان هادئ وآمن حيث بإمكاننا القراءة، الضحك، السباحة ويغمرنا الحبّ. في مكان أستطيع فيه أن أتابع دراستي وأن يكبر ولديّ دون سماع أزيز الرصاص ودويّ الإنفجارات.
كانت هذه أمنيتي في اليوم الذي فقِدتُ فيه قسراً، وآلاف من الناس مثلي، حلموا أحلاماً مماثلة وقد تبخّرت في يوم أسود من الحرب.
لا تدعوا قصّتي تنتهي هنا !
علي حمادة

علي حمادة
إسمي علي حمادة، وُلِدتُ في العام 1971 في عائلة صغيرة تتكوّن من أمّي نايفة وأنا. كل يوم، كانت توصلني الى المدرسة وهي في طريقها الى مكاتب صحيفة السفير حيث كانت تعمل. من فترة الى أخرى، كنا نستمتع بالمغامرات القصيرة هربا من أدغال مدينة العنف لزيارة بيت جدّي في القماطيّة، والتي تبعد حوالي 17 كلم عن العاصمة.
لسخرية القدر، فُقِدتُ بعد إحدى هذه المغامرات ! كان يوم الإثنين، وكنت في طريقي الى بيروت بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع جديّ. التاريخ، 26 آذار 1984 !
في طريق العودة الى المدينة، أقلّني صديق للعائلة في سيارته وكان من المفترض أن يوصلني الى تقاطع المتحف غير أنّنا لم نعد لعائلاتنا في نهاية المطاف، وببساطة اختفينا. كتبت أمّي عدّة مقالات في صحيفة السفير على أمل أن تصلني. لقد رَجَتْنِي ألا أسمح لخاطفيّ أن يزرعوا بذور الشر فيّ، وألا أدعهم يسلبونني براءتي وروح الطفل فيّ. كتبت أنّنا سنهجر البلاد حالما أعود، وعن رغبتها في حمايتي من أيّ خطر ولكنّ ذلك لم يحصل فأنا لم أعد أبداً !
وفي السابع والعشرين من كانون الأوّل 1984، وفي التاسعة مساء، تملّكها اليأس وأنهت حياتها.
كنتُ في الثالثة عشر حينما انتهت قصّتي، اليوم الذي حُرِمت أمي الأرملة من إبنها الوحيد. كثرٌ فُقِدوا مثلي خلال الأيام الدمويّة للحرب الأهليّة، وما زال أهلهم ينتظرون معرفة ما حصل لهم.
لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
ستافرو أندريوتي

ستافرو أندريوتي
إسمي ستافرو. كان عُمري 16 سنة حينَ خَرَجتُ مع أصدقائي ولم أَعُد مُنذُ حينها. كنتُ في صف البروفيه وكنتُ أكرهُ مادةَ التاريخ، لكن أمي دائماً ما كانت تُساعدُني في المراجعة بحيث كانت تُلقي عليّ الدرسَ بشكلِ قصة، وبالتالي كانت تجعل من مادة التاريخ الجافة رواية يَسهُلُ تَذَكُرَها. في المقابل، كنتُ بارعاً في مادة الرياضيات. كنتُ أريدُ أن أُصبح مهندساً كهربائياً.
كان لي شقيق يصغَرُني عمراً، لكنهُ توفى قبل بضعِ سنواتٍ عندما أصابت قذيفة شُرفة منزلنا عن طريق الخطأ. وقفتُ بجانبِ أمي ماغي بعد هذه الحادثة وكنتُ لها الدعمَ والسَنَد. لكن الحرب أصَرَّت على الإستمرارِ بنهشِ عائلتي.
في السابع من شهرِ تموز للعام 1978 خرجتُ من منزل أهلي الكائن في سدّ البوشرية لألتقي بأصدقائي ولنمضي بعض الوقت مع صديقِنا قبلَ سَفَرِهِ إلى الولايات المُتحدة الأمريكية. صَعدنا جميعاً في سيارة واتَجَهنا إلى منطقة الفنار لإحتساء بعض الشراب ولكي نُوَدِّعَهُ، ولكنَنا لم نستَطع الوصول قط. بعضُ شهود العيان قالوا أنهم قد شاهدوا سيارة صفراء اللون تتوقف ويرتجل منها رجلان مُسلَّحان، ورأوا هذيْن الرجليْن يُجبران أربعة شباب على الذهاب معهما. عائلتي مُقتنعة أن هؤلاء الشباب الأربعة هم أنا وأصدقائي الثلاث، خاصةً بعد أن قام أحد شهود العيان بوَصفِ أحد الشباب بأنهُ طويلٌ وشعرهُ أشقر ويرتدي قميصاً أزرقاً. ذلك الوصف يتطابق تماماً معي ومع ما كنتُ أرتديه ذلك اليوم.
بقيت أمي لسنوات عدة تذهب إلى المعتقلات الموجودة في كل أنحاء البلد وفي سوريا للعثور على أيّة معلومة عني. ولكن لم يأتيها أي جواب.
اليوم، لم يعد لدى أمي أمل بأنني سأرجع حياً. ولكن كلُّ ما تُريدهُ هو إرجاع على الأقل أصغر الرِفات لتتمكن من دفنِها كما يَنبغي ويكون لديها مكان لتذهب وتحزن وتكون معي.
اسمي ستافرو أندريوتي. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا !
سامية محمود

سامية محمود
إسمي سامية محمود وكنت تلميذة جامعية أعيش في موسكو (روسيا). كنت سعيدة هناك فقد كنت أشعر بالأمان ولم أكن أرغب بالعودة الى لبنان. عشر سنوات خلَتْ، قُتِل والدي وأخويّ الإثنين في تلّ الزعتر. وفي العام 1988، كانت الحرب لا تزال مستعرة ولكن والدتي اشتاقت إلي وأرادتني أن أعود لأقضي عطلة الأعياد وهكذا فعلت. زرتُ أهلي وأصدقائي وكان الأمر جميلاً. حينما حان وقت عودتي الى موسكو، كان مطار بيروت مغلقاً كما جرت العادة في وقتها. واضطررتُ مع أصدقائي – 4 فتيات وفتى واحد – أن نأخذ سيارة أجرة الى دمشق (سوريا) حيث كان بإمكاننا السفر من مطارها. وعلى طريق بيروت – دمشق، وعند نقطة المتحف الوطني في بيروت، اختطُفنا جميعاً (أنا وأصدقائي). أخِذنا مع كل ما نملك ولم يُترك لنا أثراً بعدها. تخيّلوا مأزق أمّي، وهي التي عاشت معاناة مقتل زوجها واثنين من أولادها. انتهى بها الأمر بمغادرة البلد، ولقد حزمت أمتعة كل أولادها وحتى أوراق الأزهار المجفّفة في كتابي وسافرت الى ألمانيا.
لا تدعوا قصتي تنتهي هنا !
رمزي عبد الخالق

رمزي عبد الخالق
إسمي رمزي. كنتُ في الواحدةِ والعشرين من عمري وكنتُ ادرسُ في الجامعةِ أمريكيةِ في بيروت. كانت تتمحور حياتي حولَ اصدقائي وعائلتي ولكن لم تختلف حياتي كثيراً عن باقي طلابِ الجامعاتِ في عمري. كان الإختلاف الوحيد هو إضطراري للمرورِ من ضيعٍ وشوارعٍ مجاورةٍ مكتظةٍ برجالِ ميليشياتٍ وحواجز كان من الممكن ايقافي عليها. كنتُ على عِلم بمدى خطورةِ رحلتي اليومية ولكنني لم اتوقع مواجهة أي مشكلة.
هل كان شبابي وتفاؤلي هما ما جعلاني أنكر حصول ذلك الأمرَ معي جاعلين قدري مثل قدر آلاف المساكين في تلك الأيام؟ أم كانت البيئة العلمانية التي تربيتُ بها تحِثُني على نِكرانِ مواجهةِ أي عذاب بسبب طائفتي الدينية المذكورة على أوراق هويتي؟
وفي التاسع والعشرين من حزيران عام 1982 حين مرَّ اصدقائي لاصطحابي من منزلي لم يجدوني. وبعد فترة وُجِدَت سيارتي في مرآبِ إحدى الميليشيات وتم التعرّف عليها من خلال الملصق الجامعة الأميركية في بيروت الذي كنتُ قد وضعتُ على زجاج سيارتي.
بعد مرور 34 سنة على اختفائي ما زال الأمر مصدر ألم وعذاب لعائلتي وأحبائي. غالباً ما تتسأل شقيقتي ديما إن كان خاطفيّ على علمٍ بمدى تأثيرِ أفعالهم على حياة عائلتي واشقائي.
إسمي رمزي عبد الخالق. لا تدعوا قُصَتي تنتَهي هنا.
محمد مصطفى

محمد مصطفى
إسمي محمد مصطفى وإذا زرتوا منزلي في مدينة طرابلس، ستروْن صوري تملؤه فهكذا تحافظ زوجتي على وجودي في المنزل. هي أشجع إمرأة عرفتها. وخلال الوقت الذي قضيناه سوياً، أنجبت لي ستة أولاد، غير أنّ اثنين منهما لم ينجوا. كرّست وقتها لتربية إبنيْنا وبنتيْنا وكان يقع أغلب ذلك على عاتقها لأنّني كنتُ أعمل كمهندس معماري متنقّلاً بين عُمان، قطر والرياض وكنتُ أراهم لفترة بسيطة مع مرور الأشهر.
بعد فترة، قرّرت أن أرى أولادي يكبرون معي، وهكذا وفي العام 1987، عدتُ الى موطني. استمتعتُ بوقتي مع عائلتي ولكن لثلاثة أشهر فقط، ففي تشرين الثاني من العام 1987 اقتحم مجموعة من المسلّحين منزلنا في الثالثة فجراً واقتادوني بعيداً.
كنتُ أسمع زوجتي تصيح أثناء تعصيبهم لعينيّ وتقييدهم يديّ، وحينما وضعوني في العربة وضربوني بالعصيّ، كنتُ ما زلتُ قادراً على سماع صوتها. ومنذ ذلك الوقت، لا تزال زوجتي تبحث عني وتذهب الى مراكز الاعتقال في سوريا، في لبنان .. ولم تستسلم حتى مع تلقّيها رسائل تهديد بالقتل. إنّني محظوظ بزوجة شجاعة.
لا تدعوا قصّتي تنتهي هنا.
محمد عباس

محمد عباس
اسمي محمد عباس، كنت في الرابع والثلاثين من عمري يوم فُقدت في الواحد والعشرين من شهر آب سنة 1978. ذهبت تاركاً خلفي زوجتي وبناتي الأربعة، ابتسام وأمل وسنا وسلام التي كانت فقط في العاشرة من عمرها.
كنت أسكن في المملكة العربية السعودية حيث كنت أعمل كبلّاط. قرّرت العيش والعمل هناك كالكثير من الشباب وذلك لتأمين حياة أفضل لعائلتي. كنت أحلم في العودة الى لبنان ومعي ما يكفي من المال لشراء منزل للعائلة والعيش معها.
كنت آتي الى لبنان بشكل منتظم لزيارة عائلتي وأنتظر بفارغ الصبر كلّ دقيقة يمكن أن أقضيها معها. من أحبّ الذكريات على قلبي كانت أحاديثي الطويلة مع أبي والنزهات في الطبيعة التي كنّا نقوم بها في أيام الربيع المشمسة الجميلة التي كانت تسبق أيام الصيف الحارّ.
عندما شبّت الحرب في لبنان خفت كثيراً على أحبائي. في 1978، عندما تفاقمت الأحداث قررت قيادة سيارتي عائداً الى لبنان في شهر رمضان لزيارة عائلتي وأخذها معي الى المملكة العربية السعودية حيث ستكون بأمان.
انتظرت عائلي قدومي لكنّني لم أصل. بعد أيام من الانتظار ذهب صهري الي السعودية والاردن آملاً أن يجدني لكنّه اكتشف أن رحلتي توقّفت بعد أن دخلت الحدود اللبنانية.
عانت زوجتي وبناتي الكثير نتيجة فقداني كما فاتني الكثير من حياتهم. لقد قضين معظم وقتهنّ وهنّ يبحثن عنّي ويحاولن معرفة ما حدث معي كما وأضظررن للعمل من أجل تأمين سبل العيش في غيابي.
اسمي محمد عباس. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
يوسف ميلاد

يوسف ميلاد
إسمي ميلاد. ولدت في عين مجدلين، في منطقة جزين، عام ١٩٦٥. كنت مهندساً ميكانيكياً. كنت أعمل في شركة الفولفو. عائلتي كانت دائماً تشتبه بانني معجب بإحدى اقربائي. لكنني كنت احتفظ بهذا الحب سراً...
كنت شاباً مرحاً و ضحوكاً . لم أخذ الحياة على محمل الجد. أختي جانيت كانت شركتي المفضلة في اللعب. كنا نمضي الكثير من وقتنا في التخاصم. أما أمنياً، عندما كانت المعارك تشتد و تلزمنا على الإحتواء في الملجأ، كنا نمضي وقتنا في لعب الورق.
في يومٍ من الأيام، بعد أن فازت في اللعبة، أتيت بفكرة غير صالحة. رميت تفاحةً على جانيت، فأصيب جبينها و بدأت تنزف. عقبت من قبل أبي نتيجة ذلك التصرف. لكن اليوم، جانيت لازالت تتذكر هذه الحادثة وتنظر إلى تلك الندبة الصغيرة فوق عينها، وهي مليئة بالعواطف و المشاعر.
اليوم، تلك الندبة وبعض الصور هي كل ما تبقى مني.
في ٣٠ آب عام ١٩٨٣، وعندما لم يكن يتخطى عمري ال ١٨ ربيعاً، اختفيت. كنت قد التحقت في الجيش منذ عهدٍ قريب. كنت في مركزي عند حاجزٍ قرب مطر بيروت، على طريق المشرفيه. هنا، اختطفت من قبل رجال مسلحين.
نهار الجمعة الماضية، أعلن الصليب الأحمر الدولي جمع عينات من الحمض النووي من عائلات المفقودين للتعريف عن الجثث في المقابر الجماعية.
هذه خطوة مهمة جداً، لكنها غير كافية، فيتوجب على السلطات اللبنانية تحديد مواقع المقابر الجماعية و إخراج الجثث. عندها فقط، أحبائي قد يتعرفون على مصيري و قد يكون لهم مكاناً لزيارتي، مكاناً أرقد به في سلام.
إسمي يوسف ميلاد، لا تضعوا قصتي تنتهي هنا.
ريشارد سالم

ريشارد سالم
إسمي ريتشارد. في العام 1985، كنتُ في الثاني والعشرين من العمر؛ ومنذ تحصّلي على شهادة الهندسة، عملتُ مع العائلة. أختي، ماري كريستين، كانت في التاسعة عشر من العمل وكانت على وشك بدء سنتها الجامعية الأولى. كنا شابين يافعين، ربينا في منزل مفعم بالحبّ، وما بين الدراسة والعمل، الرياضة والأصدقاء.
حينما تُوفي والدي في 1982 جراء المرض، صمّمت والدتي أوديت على إبقاء المناخ الإيجابي وروح المحبّة في المنزل. عاودت الحياكة من جديد، وقد كانت خياطة موهوبة جداً وغالباً ما كانت ترتدي فساتين أنيقة جداُ من تصميمها. حرصت على ملء الفراغ الذي تركه فقدان أبي.
ولكن مع حلول السابع عشر من أيلول للعام 1985، وعند الثالثة ظهراً، بدأت والدتنا بالقلق إذ أنّنا لم نحضر للمنزل لتناول الغذاء وتبدّلت حياتها من توفير الراحة لنا إلى البحث عنّا. في ذلك اليوم، كنّا عائدَيْن مع عمّنا جورج من الحمرا، وكانت أمّي تتوقع مجيئنا مع موعد الغذاء ولكننا لم نأتِ أبداً.
إنتظرتنا امّنا، وعانت وأمِلت لأربع وعشرين عاماً إلى أن دُهِست بسيارة مسرعة أثناء ذهابها الى خيمة انتظار المفقودين في العام 2009.
إسمي ريشارد سالم وأختي ماري كريستين سالم، لا تدعوا قصّة عائلتنا تنتهي هنا !
ماهر قصير

ماهر قصير
كنتُ الإبن البكر في عائلةٍ مؤلفةٍ من ثلاثةِ أولادٍ وفتاتين. كانت تجمعني علاقةً مميزةً مع والدتي العزيزة إذ كانت دائماً ما تساندني. حتى في ذلك اليوم الذي أخذتُ فيه السيارة وحطمتها؛ ذهبت وتكلمت مع صاحبِ السيارة الثانية وعالجت الأمر - لحسن حظي! لقد عرفتهُا على أغاني مارسيل خليفة، كنتُ اعزِفُها على الغيتار لعدة ساعات، وفي الحقيقة كنتُ أفكرُ في أن أصبحَ عازفَ غيتارٍ محترفٍ، إما ذلك أو دراسةِ إدارة الأعمال.
ولكن هذه الأحلام انتهت في 17 حزيران عام 1982 عندما لم أعد إلى منزلي. كان عمري 15 سنة ربيعاً.
منذُ ذلك اليوم كافحت والدتي لكي تجدني. لم يكن بمقدرها أن تقبل وتحزن على فقدان ولدِها من دونِ معرفةِ ما حدثَ لهُ ومن دونِ وجود قبرٍ له لإيجاد السلام. لم يعد لأي شيءٍ معنى بعد ذلك. كانت تريدُ أن تكونَ قريبةً مني حياً أو ميتاً وحاولت أن تجد بعض الراحة من خلالِ إهداءِ لوحتها لي وبالتالي ابقائي موجوداً في حياتها. واليوم كلَ غرفةِ في شقتها مليئةً بصورٍ لي.
ولكنها ما زالت تحسُّ بالضياعِ وما زالت تبحثُ عن مكانٍ حيث يُمكنها التواجدَ معي. ومُنذُ اعوامٍ قليلةٍ وعلى الذكرى السنوية لي، ذهبت ووضعت وردةً في المكان الذي فُقِدّتُ فيه؛ المكان الأخير الذي كنتُ فيه قُبيلَ اختفائي. وكان ذلكَ المكان العلامة الوحيدة والشيء الوحيد الذي لهُ معنى لها والذي يُمكن أن يُخفِفَ من عذابها.
ومُنذُ ذلكَ الحين قامت والدتي بزرعِ شجرةٍ ذكرةً لي. واليوم تقوم بزيارةِ هذا المكان في كل مرةٍ ارادت أن تكون قريبةً مني.
أودُّ كثيراً أن تجدَ الأجوبة وبالتالي تجدُ الراحة.
إسمي ماهر قصير ووالدتي هي مريم سعيدي. لا تضعوا قصتي تنتهي هنا.
خالد شحادة

خالد شحادة
إسمي خالد، وفي عام 1984 كان عُمري 14 سنة ربيعاً وكنتُ ادرسُ في إِحدى المدارسِ الثانويةِ في صيدا. كنت ولداً سعيداً وكنت دائماً أمازِحُ أخي واخواتي الأربعة. تذكرُ والدتي أنه عندما كان والدي يعطينِي المالَ لحلاقةِ شعري، كنتُ أعودُ إلى المنزلِ في الليلِ وشعري لم يمِسُّهُ أحد. فكنتُ اصرِفُ تلك الأموالَ على المثلجاتِ.
وفي 16 آذارعام 1984, خرجتُ في نزهةٍ مع أخي فادي. في بداية الأمر، وعندما لم نعودُ إلى المنزلِ، لم يقلق والِديّ إذ ظنّوا بأننا كُنا نمرحُ كثيراً وفقدنا الحسَّ بالوقت. ولكن في تلك الأوقات كان وباءُ الحربِ سائداً مما دفع والِديّ إلى القلق. وفي ذلك الحين، كانوا قد سمعوا الكثير من القصص عن أشخاص تمَّ اختطافِهم.
بعد أيام ٍقليلةٍ طلب والِديّ المساعدة من أحدِ معارفِهِم لمساعدتِهِم في العثورِعلينا. طلبَ هذا الشخص $12000 من والِدِي ووعدَهُ بأننا سنعود الى المنزلِ قبلَ حلولَ الليلِ. مفعماً بالأمل، دفعَ والِدِي هذا المبلغ ومَلأت الفرحة والدتي. وكانت قد اعدت لنا طوال النهار العشاءَ الذي كان مؤلفاً من كل وجباتِنا المفضلةِ. ودَعَت جميعَ أفرادِ العائلة والجيران إلى المنزل كي يتمكنُوا من الترحيب بنا. ولكن مرَّت ساعات ولم نرجَع. وحوالي منتصف الليل، عاد الجميع إلى منازِلِهم. وبقي والِديّ وقلوبِهِم مفعمةً بالحسرة.
إسمي خالد شحادة. أخي فادي شحادة. لا تضعوا قصتنا تنتهي هنا.
جهاد عيد

جهاد عيد
إسمي جهاد ومنذ صغري أردتُ أن اتبعَ خطواتِ جدّي بالإنضمامِ إلى الجيش اللبناني. وعندما بلغتُ العشرينَ من عمري حققتُ حلم الطفولة وأصبحتُ جندياً بينما كنتُ أُتابع دراستي في علم الحاسوب في الجامعة اللبنانية.
لم يكن انضمامي إلى الجيش كما توقعتُ إذ لم أدرك كم كبر التضحية لخدمةِ الوطن.
وفي تشرين الأول عام 1990 إنتقلَ مركزي في الجيش إلى منطقة السانت تريز في الحدث على بُعد خمس دقائق من منزلِ أهلي. تَمكنت أفواج من الجيش السوري من الدخولِ إلى المنطقة وقاموا بإطلاقِ الرصاصِ علينا. أدَّى ذلك إلى اصابتي في رجلي واصابت زميلي كلود بجروحٍ قاتلة. وثم أخذني الجنود السوريين إلى مركز الإعتقال في "بو ريفاج". بعد ثمانية عشرَ يوماً بُعِثتُ إلى عنجر ومن بعدها إلى سوريا. عَلِم أهلي بالأمر من قبل زميل لي كان قد تم الإفراج عنه.
ضحت أمي كثيراً من أجلي، إذ قامت بإنفاقِ جميع مدخراتها للسفر إلى سوريا. وفي بعض الأحيان اضطرت أن تدفع لبعضِ الظُبات للحصولِ على معلومات بمكان إحتجازي. وبعد سنة من إختفائي تمكنت من إيجادي ولكن لقائنا لم يكن سعيداً.
مشهد الإستقبال فور وصولها إلى السجن كان مروعاً إذ رأت سبعة مساجين مقيدين وحافين الأقدام ومعصوبين الأعين. كانت الدماء تملأ وجوههم وأعناقهم واذانهم... وواحدٌ منهم كان يشبهني. ارادت والدتي الصراخ وارادت أن تعرف أياً من الجنود ولدها. ولكن الصدمة طغت عليها ولم يكن بإستطاعتها فعل أي شيء. أُغمي على والدتي ولا زالت تلك الصور تطاردها حتى اليوم.
لم تفقد والدتي الأمل. منذُ زيارتها للسجون السورية لم تتوقف عن الإخبار عن فظاعة الوضع وعن طلب المساعدة. أصبحت والدتي رئيسة لجنة أهالي المعتقلين في سوريا وشاركت في الإعتصامات اليومية في خيمة أهالي المفقودين. تأمل والدتي لتأثير بالرأي العام والسلطات اللبنانية من خلال إظهار يأس العائلات ومدى تأثرهم بالوضع.
واليوم تعبت والدتي واستنفزت نتيجة عدم تحرك البعض وتخييبهم لامالها وامال الأخرين. أعلم بمدى اشتياقها لي وأعلم بأنها لن تنساني أبداً فهي لا زالت تحتفل بعيد ميلادي كل سنة.
إسمي جهاد عيد ووالدتي سونيا عيد. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا
حنا مخلوف

حنا مخلوف
إسمي حنا ومنذ ٣٧ عاماً وفي هذه الفترة تقريباً، كنتُ اذهبُ من منزلي في الضبيّه إلى قريتي في بقعكفرا لألحق بزوجتي وأولادي الستة الذين كانوا يقضون آخر أيام الصيفِ هناك.
اُوقفتُ على حاجزٍ عائدٍ إلى إحدى الميليشياتِ أثناء عبوري قرية اميون. وبعدَ استجوابي من قبلِ رجالِ الميليشيا طُلِبَ ميني الترجل من السيارةِ التي كنتُ قد اشتريتُها مؤخراً والتي كانت من نوعِ "سمكا" وعدم العودةِ مجدداً.
فورَ وصولي إلى بقعكفرا بدأتْ تفاصيلَ حادثتي في اميون بالإنتشارِ بين الناس. باتَ أهلُ قريتي بالتجمعِ في منزلِ والدي الذي كان مختارَ القريةِ في ذلك الحين. بعد طولِ النقاشات حول الأمر، قررنا التواصلَ مع بعض الأشخاصِ في اميون الذين كانوا على معرفةٍ بوالدي لمساعدتِنا في العودةِ إلى الحاجزِ ومفاوضةِ رجال الميليشيا لإسترجاعِ سيارتي.
لم نتخيلْ بأنّ تلكَ المفاوضة البسيطة كانت ستؤدي بإحتجازي أنا ووالدي.
بعد فترةٍ قصيرةٍ من اختفائي، زارَ رجلٌ كان قد تمّ إلإفرجَ عنهُ عائلتي. أخبرَ زوجتي كيف كان والدي يتوسل الرجال الذين كانوا يقومونَ بتعذيبي إلى التوقفِ عن ضربي لأنني ربَ منزلٍ وعلي العودةِ إلى عائلتي. كان يطلبُ منهم تعذيبِه بدلاً عني. بالنسبةِ إلى ذلك الرجل، توفي والدي بعد فترةٍ قصيرةٍ من التعذيب. لم تعلم عائلتي إنّ كان مصيري مماثلاً أم إنّ كنتُ قد أخذتُ إلى مركزِ إحتجازٍ في سوريا.
"إختفى والدُكَ ولا نعلم إن كان سيعود."
كيف بإستطاعةِ أيّ شخصٍ زفّ هذه الأنباءِ إلى أولادٍ صغار.
كان ابني جورج في السابعة من عُمرِه في ذلك الوقت. كان يذكر كيف لُقبَ ب"إبن المخطوف" في ضيعتنا. لم يفهم معنى كلمةَ مخطوف ولكنه لاحظَ كيف بدأ الناس بمعاملتِه بلطفٍ أكثر بعد أن اطلقوا عليه ذلك اللقب. ظنَّ جورج بأن كلمةَ مخطوف تدلُّ على ميزةٍ كسبَها والدَهُ بعد القيامِ بإنجازٍ كبيرٍ وأنّ تلك الميزةِ هي السبب في معاملةِ الناسِ لهُ بلطفٍ وإحترام.
سيتأذى بعد فترة عندما يسأل "أين والدي؟"
إسمي حنا مخلوف ووالدي هو وديع. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
هادي كرم

هادي كرم
أسمي هادي. كنتُ الشاب البالغ من العمر 28 عاماً والشاب المحبوب والمدلل من قبل أخواته الثلاثة اللواتي ركزوا كل اهتمامهم على أخيهم الوحيد. كنتُ أعملُ مع والدي في شركةِ الطباعةِ العائدة لعائلتنا في جبيل. ولكن في سنة 1989 وبعد مرور 14 عاماً على الحرب، كنت قد اكتفيت. أردتُ المغادرة والعيش في تولوز، فرنسا. ولكن اضطررتُ إلى وضع هذا الحلم جانباً إذ أبي لم يقدر أن يتخيل رحيلي عنهُ.
وفي 14 حزيران عام 1990, جاء رجل إلى عملي وسألني إن كنتُ ارغبُ في بيعِ سيارتي وكنت قد وجدتُ هذا الأمرَ غريباً وخاصةً بعد أن لاحظتُ أن هناكَ سيارة تتبعني منذ أيامٍ عدة. لاحقاً في نفسِ اليوم، غادرتُ العملَ لحضورِ حفل زفافٍ في دوما. ولكن قبل تركي العمل كنتُ قد اتصلتُ ببائع الورود لتجهيزِ باقةٍ من الورودِ ولكن للأسف لم أصل إلى هناكَ لاستلامها. لقد ذعروا اصدقائي عندما لم يروني في حفلِ الزفاف ولكن فكرةَ اختفائي لم تعبر عقولهم أبداً.
مثل الآلاف من الأسر الأخرى، تأثر والدي كثيراً لدى اختفائي إذ قد يكون قد تأسفَ على عدم سماحهِ لي بالإنتقالِ إلى فرنسا. إذ توفي بعد وقتٍ قصير من اختفائي. أما بالنسبة لشقيقتي هيلدا، لقد استمرت بانتظاري حتى عندما اُتيحت لها الفرصة بمغادرةِ لبنان والعملِ في الخارج، قررت البقاء في لبنان في حال رجوعي. واليوم تتذكر بمحبةٍ وإعزاز كل الأوقات التي كنت العب مع اولادها، وكل الأوقات التي كنتُ أقومُ بإعادتهم إلى البيت متسخين من رأسهم إلى أصابعي اقدامهم وتتمنى لو أن اولادها يمكنهم أن يتذكرني... وترغب أن تعلم ما حدث لي وأن تتمكن من تفسيرها اليهم.
إسمي هادي كرم. لا تضعوا قصتي تنتهي هنا.
فاطمة العلي

فاطمة العلي
اسمي فاطِمة، وأنا أم فخورة لأربعة أطفال. على الرغم من أن ظروف الحرب قد أثرَّت كثيراً على حياتنا، لقد عَملتُ بجدٍ لأتحمل الوِزِرَ والمسؤوليةَ لكي أعطي أولادي طفولةً سعيدة، وتعليماً حسناً.
إبني عدنان، والبالغ من العمر ثمانية أعوام، كان الأكبر سناً بين أولادي. كان جيداً جداً في مدرَسَتِهِ وكان يُحبُ أن يزورُنا الناس، فهو كان دائماً يُرحب بهم بحماس. إبني عصمت كان يبلغ من العمر مجرد 6 سنوات، ولكنه كان رشيداً جداً بالنسبة لعمرِهِ. فاديا كانت ابنتي الوحيدة، كان عُمرها 4 أعوام. كانت فاديا لطيفة جداً وكانت تُحب اللعب مع ألعابِها. إبني الأصغر فادي كان لا يتعدى السَنَتَيْنِ من العمر، وكان صبياً هادئاً و لم يكن صعباً على الإطلاق.
على الرغم من انني بذلت أقصى ما بوسعي، لقد سُرق مستقبل أولادي وطفولتهم. كنا نسكن في مخيم تل الزعتر. وفي عام 1976 بعد أيامٍ عدة من الحصار، اعتقدنا أنه بإمكاننا الفرار بسلام، ولكن لم نستطع. لم نُرى مجدداً بعد ذلك. أولادي كانوا صِغاراً جداً. كان يجب أن يَحظوا بالمزيد من الوقت .
في ذلك الوقت، كان زوجي في ألمانيا، ولقد خَسَرَنا جميعاً في آنٍ واحد. بعد ذلك، رفضت أمي العيش بشكلٍ مريح. شعرت بالذنب والحزن الشديد لدرجة أنها كانت تنام على الأرض. استمرت أختي بالبحث عني بلا كلل. وغالباً ما اقتربت من فقدان الأمل، ولكنها لم تفقده ولا حتى لمرة. واستَمَرّت تناضل للحصول على إجابات حول ما قد حدث لي ولأولادي.
إسمي فاطمة العلي. أولادي هم عدنان وعصمت وفادية وفادي. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا!
علي فارس

علي فارس
إسمي علي وأنا من منطقة شحور الواقعة بالقربِ من مدينة صور. عندما أذكرُ كلّ الأوقات التي قضيتها مع عائلتي قُرب النهر وكل رحلات الصيد مع اصدقائي، أشعرُ بمدى اعجابي بتلك المنطقة... لم أنوي على مغادرةِ ضيعتي ولم يكنْ هناك شيئٌ سيجبرني على ذلك. ولكنني وقعتُ في غرامِ فتاةٍ من بيروت. التقينا لأول مرة خلال عطلة نهاية الاسبوع التي قضتها عند ذويها في ضيعتي. كنتُ اذهبُ إلى بيروت في نهايةِ الاسبوع عند صديقي حسن كلّ ما سنحَت لي الفرصة للتمكن من رؤيتِها. كان حسن صديقَ الطفولةِ وكان قد تركَ المدرسة وغادرَ من ضيعتِنا إلى بيروت للعملِ والعيشِ هناك.
في الثاني والعشرين من أب عام ١٩٨٣، بينما كُنا ذاهبين للقاءِ الفتاةِ التي نويتُ الزواجَ بها، تم اختطافنا. لم ترني أختي مريم من بعد ذلك رغم انني وعدتها بالعودةِ إلى منزلنا في شحور وقطف اللوز من شجرةِ ابي في اليوم التالي.
بحث عني اقربائي في كلِ مكانٍ وكان الجواب الوحيد والمشؤوم الذي حصلوا عليه هو التالي "يقومون بعدّ السجناء كما يعدّون الغنم وان قاموا بملاحظة إن احدَهُم قد إختفى، سيجن جنونهم، فالطريقة الوحيدة للافراج عنهُ هي من خلال إيجاد شخصاً يحل محلهُ".
لم نكن سوى أرقام بالنسبة لهم،أم "فراطة"، أم بيادق الشطرنج في لعبةِ انتصارهِم المحتمل.
إسمي علي فارس، صديقي حسن زين، لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
أحمد خانج

أحمد خانج
إسمي أحمد ولديّ شغفٌ للإلكترونيات. شغفي شديدٌ لدرجةِ أنه بإمكاني قضاء ساعاتٍ طويلةٍ أعملُ على معداتي وأقومُ بتجاربٍ في مختلفِ أنحاءِ المنزلِ. أحد اختباراتي كانت تطويرَ بابِ منزلِنا لكي يفتحَ بكبسةِ زرٍ. يبدو الأمر عادياً في الحاضر ولكن في تلك الأيام كان من علاماتِ الإبتكار!
كنتُ أعملُ في محمصة الأمين لكسبِ عيشي. ساعدني عملي على إعالةِ والدتي وأخوايّ واختي. كنا نعيشُ سوياً في منطقة الميناء في طرابلس. كنا على مقربةٍ من بعضنا البعض وزادت صِلتنا ببعض بعد وفاةِ والدي.
في شهر أيلول عام 1985 تدهورت الأوضاعُ الأمنية في طرابلس. غادرتُ طرابلس بسببِ الأحوالِ وبقيتُ في عكار عند إحدى اخوتي. في تلك الأيام كان جميع اخوتي الكبار يقطنونَ بعكار. طلبتُ من والدتي واختي الصغرى مرافقتي لأنني علمتُ بأنهم سيكونونَ على مأمنٍ هناك.
دفعني تصميمي لإحضارِهم إلى عكار وإلى المغادرةِ إلى الميناء بصحبةِ إثنين من اصدقائي. ولكن في طريقِنا إلى طرابلس تم توقيفُنا على حاجزِ الملوله.
بعد مرورِ بضعةِ أيام، وجدَ اقربائي سيارتي المهجورة قربَ الحاجزِ. عندما سألوا الجنودَ هناك عن مكانِ وجودنا اجابوهم بأننا نخضعُ للإستجوابِ وسيتم الإخلاءَ عن سبيلنا قريباً. كنتُ في الرابعة والعشرين ربيعاً.
منذُ ذلك اليوم وتحلمُ بي أختي مراراً. تتخيلُني عائداً للمنزلِ بجسمٍ هزيلٍ وبثيابٍ ممزقةٍ ومتسخةٍ. تتخيلُني وأنا أسألُها عن سببِ عدمِ بحثِها عني لتلك المدةِ الطويلةِ.
إسمي أحمد خانجي وإسم أختي جاذبة. وهي لا زالت تلومُ نفسِها لعدمِ إيجادي حتى الأن. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
عبـد الـرؤوف أحمـد خليـل

عبـد الـرؤوف أحمـد خليـل
إسـمي عبــد الرؤوف. كنــت ً شــخصا ً نشيطا ً وطموحا لا يتجـاوز عمــري الستة والثلاثون عاما . عــدت إلــى لبنــان للعمــل كتقنــي مختبــر فــي منطقــة البربيــر بعــد دراسـتي الطـب فـي جامعـة القاهـرة فـي مصـر. وفـي نهايـة اليـوم، كنـت ُ أخـرج مـع اصدقائـي إلـى مقهـى يدعـى "مريلانـد" فـي منطقـة الروشة، والـذي استبدل اليـوم بفندق ال"موفنبك". كنــت ُ اذهــب دومــا ً إلــى طرابلــس حيــث انشـأت لــي معرضــا لبيـع السـيارات. كنـت ُ أمـر إلـى منـزل والدتـي بعـد كل رحلـة لـي إلـى هنـاك لاعطائهـا الحلــوى التــي كانــت تحبهــا.
جميـع اقربائي يتذكرون حبي للبنان إذ سنحت لـي فرص كثيـرة للسـفر ولكنـي كنت دائمــا متشوقا للبقــاء فــي هــذا الوطــن. وكذلــك لــم أفوت أي فرصــة للتجــول فــي لبنـان مـع أخي طـلال الـذي كان يرافقنـي في كل مغامراتي. وإحدى تلـك المغامرات، والتـي كانـت عزيـزة جـدا علـى قلبـي، هـي مشـروعي التعليمـي الـذي كان يهـدف إلـى تحسـين ثقافـة الشـباب فـي وطنـي. كانـت خطتي تتضمن إنشـاء كليـةٍ مهنيـةٍ حيـث يتأهل الطلاب لدخـول مجـال العمـل بطريقـة أفضـل. كانـت لدي طموحات كثيرة لوطني لبنـان. وكنـت امتلك الكثيـر مـن الطاقـة للاسـتثمار.
إلا أن كل ذلـك توقـف فـي ذلـك اليـوم المصيـري فـي شـهر أيلـول عـام 1982 عندمـا فقـدت أثنـاء عودتـي إلـى طرابلس.
تعذب والداي كثيرا لجهلهما مصيري وقد توفيا دون أن يعرفا ما حدث لي.
إسـمي عبـد الـرؤوف أحمـد خليـل، ولطالما أحببـت وطنـي, ولكـن يبـدو أنـه قـد تخلـى عنـي. لا تدعوا قصتـي تنتهـي هنـا.
هنرييت حداد

هنرييت حداد
إسمي هنرييت وهذه الصورة هي الصورة الأخيرة لي في لحظاتٍ سعيدة.
كنت أبلغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً وكان لدي عشرة أحفاد. أحببت رعايتهم إذ كانت تجلب لي السعادة. كما أحببت مشاهدتهم وهم يكبرون واللعب معهم ورؤية الضحكة على وجوههم. لم أكن أرضى بمقايضة إمضاء وقتي معهم بأي شيء في الدنيا.
لكن في نفس الوقت، بقيْتُ في كوني إمرأةً نشطةً ومُستقلّة. كان لي عادة الاستيقاظ في الصباح الباكر لكي يكون لي ما يكفي من الوقت للوفاء بجميع المهام المبينة لذلك اليوم.
قبل إندلاع الحرب، كنتُ قد فتحتُ متجراً للملابس وكنتُ أحبُ العمل فيه والإهتمام به. ولكن، ومثل الكثير من اللبنانيين، أجبرتنا الحرب على الإنتقال وترك كل شيء وراءنا.
إنتهى الأمر بي وبزوجي بالإنتقال إلى أمريكا الشمالية للإنضمام إلى أولادنا الثلاثة الذين كانوا يعيشون هناك.
مع ذلك، كلما كانت الأمور تهدأ في لبنان كنا نعود للزيارة. كنا نريد رؤية أقربائنا الذين تركناهم ورائنا والإستمتاع بالأشياء التي قد غابت عنا بينما كنا خارج الوطن، ولو كان ذلك لبضعة أيام فقط.
عُدتُ إلى لبنان في أيلول من عام 1985، وكانت تلك هي زيارتي الأخيرة. لقد خُطفت في 26 أيلول بينما كنتُ أعبر بالسيارة خط التَماس بجانب المتحف الوطني.
بينما كنا نظّنُ أننا قد أبعدنا عائلتنا عن العنف من خلال رحيلنا، إلا أن الحرب استطاعت اللحاق بنا.
بعد مرور سنين عدة على اختفائي أتى شخص إلى أقربائي وقال لهم بأنهُ كان جاراً لي في قبو الاحتجاز في مركز يقع في منطقة البسطة. كما قال لهم في حينها أنني كنتُ أردد بإستمرار أسماء أولادي الأربعة.
بالنسبة لعائلتي، فلقد كانوا في بادئ الأمر مُرتبكين وضائعين، ومن ثم أصبحوا يشعرون باليأس والعجز.
ثلاثون عاماً قد مرَّت وما زال جرحُ عائلتي مكشوفٌ ومؤلم.
ومع ذلك، لا تزالُ أيضا ذكريات وصور اللحظات السعيدة التي قد قضينا كأسرة واحدة.
اسمي هنرييت حداد. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا .
نيكولا حيدر

نيكولا حيدر
اسمي نيكولا وكنتُ رئيس مكتب البريد في منطقة فيع في الكورة.
نفّذتُ مسؤولياتي بدقة شديدة إذ أشرفتُ على الموظفين وحافظتُ على علاقة جيدة معهم ومع أبناء القرية. وبصراحة، دوماً ما كان منزلي مليئاً بالزوار الذين عبروا عن تقديرهم لي وكرمي و حسن ضيافتي.
في سن سبعة وخمسين، لم يكن لدي سوى سنواتٍ قليلة حتى أتقاعد ودوماً ما كنتُ أحلم بالأيام التي أبدأ فيها برعاية أشجار الزيتون لدي بالإضافة الى لعب الورق مع أصدقائي.
لكن في 11 كانون الثاني من عام 1979، تحطمت تلك الأحلام فجأةً.
كانت الأمطار تهطل بغزارة في ذلك اليوم الشتوي. توقفت سيارة أمام منزلي وخرج رجلان منها. طرقوا باب منزلي وقالوا لي أنهم يريدون إرسال رسالة الى أحد أقاربهم. عندئذن، قامت زوجتي أسما بدعوتهم الى الداخل وعرضت عليهم شرب فتجان قهوة.
بعد أن دخلولهم وجلوسهم في غرفة المعيشة، ذكر الرجلان بأن هناك شخصاً ينتظرهم في السيارة. عندها، ذهبتُ الى الخارج لكي أدعوه للإنضمام إلينا. حالما وصلتُ الى السيارة، قام الرجلان باجباري الى داخلها وسرعان ما هربوا وأخذوني معهم.
اسمي نيكولا حيدر. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
نزيه آغا

نزيه آغا
إسمي نزيه ولكني كنتُ معروفٌ بإسم رياض. كُنتُ مُتأهلاً وأباً لخمسة أولاد تتراوح أعمارهم بين السنتيْن والعشرة سنوات.
كنا نمكثُ في صيدا حيث كُنتُ أعمل كصيادِ سمك. كنتُ أستيقظُ عند الفجر وأذهب إلى البحر لكي أتصيّد ومن ثم أبيعُ الأسماك التي اصطدتها إلى زبائني في كلّ أنحاء المدينة.
إعتاد إبني البِكر فاروق أن يرافقني دائمًا. لكن في الآونة الأخيرة كُنتُ أرفضُ طلبه بسبب تدهور الوضع الأمني. فلقد اختبرتُ بنفسي مدى سوء الحالة الأمنية عندما قامت عناصر مسلحة بتوقيفي وإحتجازي، ليُطلقوا سراحي بعد فترةٍ قصيرة بعد أن تدخل أحد زبائني؛ والذي كان طبيباً من منطقتنا، وأقنعهم بالإفراج عني.
هذه الحادثة جعلتني أُصبح قلقاً في معظم الأحيان. لكن رغمَ ذلك، لم أستطع الحدّ من عملي كبائع سمك كونَهُ العمل الوحيد الذي كان يُأمّن لقمة العيش لعائلتي.
لكن، في إحدى الأيام وبينما كُنتُ ذاهباً الى عبرا، أُوقفتُ على حاجز. كَوني كُنتُ معروفاً من قبل سكان المنطقة بما أنهم كانوا زبائني، فورَ مشاهدتهم للحادثة، سارعوا بالتواصل مع زوجتي جميلة لإخبارها بأنه قد تم احتجازي من قبل رجال ميليشيا. ولكنها عجزت عن الذهاب الى مكان إحتجازي في ذلك اليوم لأن الجيش الإسرائلي كان قد قام بفرض حظر تجول في المدينة.
في صباح اليوم التالي، ذهبت جميلة الى الحاجز عينه وتعرفت على دراجتي النارية. ولكن الرجال المسلحون نكروا رُؤيتي هناك. هم قاموا بنفي ذلك بينما كانوا يقلون السمك الذي بدا واضحًا أنهُ السمك الذي كُنتُ قد إصطدته أنا. قامت زوجتي بعد ذلك بطلب المساعدة من الطبيب الذي جعلهم يطلقون سراحي في المرة السابقة، ولكن هذه المرة لم يكن بإمكانه أو بامكان أي شخص آخر فعلَ أي شيء.
بعد مرور إثني وعشرين عامًا على اختفائي تُم العثور على رفات بشرية داخل بئر بالقرب من مدينة صيدا. فلقد تم إيجاد ثمانية جماجم مع بقايا بشرية أُخرى. لم يكن باستطاعة زوجتي وأولادي معرفة ما إذا كُنتُ من بين هؤلاء الضحايا. وما زال الشك يُراودهم حول مصيري. أما اليوم، فأنا لستُ على قيد الحياة ولستُ في عداد الأموات. يمكن قراءة هذا الغموض الذي يلفُّ مصيري في دعوات زفاف أولادي. إذ أراد كلّ من فاروق ونسرين وفادي وفردوس كتابة إسمي بالقرب من إسم والدتهم، ولكن دون وجود كلمة "مرحوم".
إسمي نزيه آغا (رياض). لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
نزار القرطاوي

نزار القرطاوي
إسمي نزار وأنا من منطقة الزاهرية في طرابلس.
كُنتُ الأخ البكر في عائلة مؤلفة من سبعة أولاد. توفي والدي في صغري واضطررت لترك المدرسة عندما كنت في صف الخامس فقط للعمل ومساعدة والدتي بإعالة العائلة. كان عمي قد وجد لي عملاً في كراجِ أحد رفاقه لتصليح السيارات. سارعتُ وأغتنمتُ بتلك الفرصة وبعد فترة قصيرة انتهى تدريبي وأصبحت بارعاً بعملي حيث تمكنت من فتح كراج خاص بي بالقرب من مدرسة غنوم الزاهرية.
عملتُ بجهد ولكن لم يمنعني ذلك من الموازنة بين عملي وأصدقائي. إذ كنت أجتمع مع أصدقائي في الليل وللإستماع والرقص على أغاني فرقتين أسطورتين: فرقة الآبا والبي جيز. بالإضافة الى أصدقائي، كُنت أعشق فتاة إسمها هنادي. كانت تصغرني في السن ولم يرضى والديها عن علاقتنا. ولكنّي كُنتُ مستعداً للإنتظارها، إذ كُنتُ أبلغ من العمر مجرد تسعة عشر عاماً وكنتُ اعتقد أنه لدي حياة طويلة أمامي.
في 1 كانون الثاني من عام 1983، ذهبتُ مع صديقي الى الكورة للحصول على قطعة غيار لسيارته. ولكن بينما كنّا على طريقنا الى هناك، صادفنا رجالاً مسلحين كانوا متمركزين على حاجز في منطقة بحصاص – الكورة. ولم نبعُد عن تلك النقطة.
قال الكثير من الشهود بأنهُ قد تم أخذنا وحجزنا في سجن أميون. ولكن كانت والدتي قد ذهبت الى ذلك السجن عدة مرات ولم يُسمح لها بالدخول إليه أبداً. رغم ذلك، بقيَت والدتي تذهب الى هناك يوم بعد يوم الى أن أتى اليوم وأبلغوها بأنني لم أعد هناك.
وبعد تسعة عشر شهراً من إختطافي، زارها شخصٌ كان يعمل مع زوجِ شقيقتي وأعاد لها الأمل برؤيتي مجدداً. فلقد قال لها بأنهُ كان مُحتجزاً معي داخل سجن في منطقة فيح بالكورة ، كان يُطلق على ذلك المكان إسم الكهف. هذا الشخص كان قد أُعتقل قبل فترة مع زملائه في العمل وأُطلق سراحهم بعد حين.
ولكن عندما ذهيت والدتي الى ذلك السجن، لم تجد شيئاً غير الفراغ العامر.
إسمي نزار القرطاوي. قصتي لا تنتهي هنا.
مصطفى صفا

مصطفى صفا
اسمي مصطفى وكان عمري أربعة عشر عاماً وكنتُ أدرس في مدرسة الغبيري. لم أكن طالباً جيداً. وكانت تتمنى عائلتي لو كنتُ ناجحاً في المدرسة كما كنتُ ناجحاً في جعل أصدقائي يضحكون. ولكن كنتُ أُحبُ الرسم وكان لدي كُرّاسة رُسوم تخطيطيّة التي ملأتها في ذلك الوقت برسوم كريكاتورية وصور شخصيات سياسية؛ من الرئيس السابق الى أمين عام الأمم المتحدة السابق مروراً بالمسؤوليين. كُنت أستمتع بمشاهدة نقاط ضعف شخصياتهم وتناقضاتهم.
كما كان لدي شغف للسينما وكلما كان لدي القليل من المدخرات، كنتُ أذهب الى سينما الريفولي - التي كانت في وسط بيروت - لمشاهدة فيلماً. عادةً، كنتُ أذهب برفقة شقيقتي أو أعز أصدقائي هشام. أذكر أنني قد رأيتُ مع شقيقتي فيلم "الطيور" للمخرج هيتشكوك.
ولكن في إحدى الليالي في شهر أيلول عام 1975، صادفتُ هشام حينما كنتُ متوجهاً الى منزل خالي في رأس النبع لقضاء الليلة عنده. ولكن إقترح هشام بالذهاب لمشاهدة فيلماً ولم يتطلب الأمر الكثير من الوقت لإقناعي بتغيير مخططاتي.
وعندما كنا على وشك الدخول الى سينما الريفولي، اندلعت طلقات رصاص. إذ أسرعنا بالخروج لإيجاد مأوى وما إن لبث أن وجد مأوًى، نظر هشام الى الوراء ولاحظ بأنني لم أعد ورائه. أمضى الليل كله وهو يبحث عني ورفض مواجهة الواقع بالإضافة الى إمكانية إخبار والدتي عن نبأ فقداني. ولكن في الصباح اليوم الثاني، دخل الى منزلي في الشياح مهزوزاً ومشوشاً.
كانت تتناول والدتي الإفطار مع شقيقتيّ في الفناء الخلفي عندما انهارت الأرض تحت أقضامهم. ولكن بعد فترة وجيزة من تلك الصدمة، جمعوا كل القوة التي كانوا يتملكنوها وبدأوا بالبحث عني في المشارح.
ولكن دون جدوى، لم يجدوا شيئاً. ولا أثر. لم يكن هناك رفات حتى.
اسمي مصطفى صفا. قصتي لا تنتهي هنا.
محمد العويّك

محمد العويّك
اسمي محمد. جُلَّ ما كنتُ أحب كان عملي بزراعة الأرض. كنتُ أُعاني في المدرسة في صغري إذ لم يكن بإستطاعتي الجلوس طوال النهار خلف طاولة الدراسة. كنتُ دوماً أشعرُ بالملل الشديد، فرغبتي الوحيدة كانت الإنضمام إلى والدي ومساعدته بتحصيل الخيار. أخيرًا وافق والدي أن أُخلي طاولة الدراسة عندما بلغتُ من العمر إثنيْ عشر عامًا ومنذ حينها أصبحتُ أساعدهُ في الحقل.
بعد فترة وبعد أن أصبحت أكبر سناً، حاولت الإلتحاق بالجيش. لكن بعد مرور عامًا واحدًا عُدتُ الى المنزل وأنا متيقّن بأن حمل السلاح لم يكن يناسبني. فبالرغم من كوني شخصًا محبّاً لوطنه، شخصيتي المندفعة وحبي للحرية لم يكونا مناسبيْن لزيّ الجندي الصالح. فكنتُ أفضل لعب دور الحكم مع أشقائي وشقيقاتي وتقديم المساعدة عندما كانوا يحتاجونَ حمايتي.
في أحد الأيام من عام 1985 اُصيبت أمي بالإنهيار. كان قد أُلقِيَ القبض على إبن أختها محمود في طرابلس، وقُمتُ أنا – دون أن أفكر بالأمر- بالإسراع لللِحاقِ به والعثور عليه. كان محمود ذو ثلاثة عشر عامًا فقط. وبالرغم من كل جهودي، لم يكن بمقدوري أن أفعل شيء. كِلانا لم نرجع إلى البيت في ذلك اليوم.
إسمي محمد العويّك، إبن خالتي اسمه محمود العويّك. لا تدع قصتنا تنتهي هنا.
محي الدين حشيشو

محي الدين حشيشو
في ١٥ أيلول ١٩٨٢، بينما كنت جالساً في منزلي وانا أطالع، إقتحم رجالٌ مسلحون منزلي وطلبوا مني الذهاب إلى التحقيق.
ارتعبت زوجتي وأولادنا لكنها امتنعت عن التظاهر خشيةً من تفاقم الأمور اكثر. لكن كان مصيري مهيأً، لم أكن لأعود بتاتاً.
إنتظر كل من أسامة (في ال ١٨ من العمر)، هدى (في ال١٥من العمر)، منى (في ال ١١من العمر) و مازن (في ال٩ من العمر) عودتي على مدى سنواتٍ عديدةٍ. لكن دفعتهم شدة الأوهام الى الهجرة بعيداً من هذه البلاد التي أرغمتهم على العيش بجوار خاطفي والدهم اللذين لم يتم محاسبتهم قطعاً.
لم تتوقف زوجتي نجاة يوماً عن المكافحة. رفعت دعوة على ثلاثةٍ من خاطفييي بعد التعرف على هويتهم. واجهتهم للإستماع إلى اعترافاتهم ولمعرفة مصيري أخيراً، وهي مسلحةٌ فقط بشجاعتها وتصميمها.
لكنهم سلبوها حتى حق معرفة المصير. وبعد ٢٨ عاماً من المحاكمة و الجلسات المحالة والضغوطات السياسية، اُسقطت كل التهم والدعاوى الموجهة ضد المعنيين الثلاثة.
لكن نجاة لم تستسلم بالرغم من صعوبة ومراراة الواقع. لا تزال صامدةً إلى جانب أهالي المفقودين. لكنه يجدر الذكر انها تمضي كذلك بعضاً من وقتها في المهجر قرب اولادنا الذين لكلٍ منهم عائلاتهم.
في ١٥ أيلول عام ٢٠١٢، بعض مرور٣٠ عاماً على اختطافي، أبصرت حفيدتي جنى النور. كانت ولادتها بمثابة فرحةٍ كبيرة لعائلتي لكنها كانت أيضاً صدفةً غريبةً، وكأنها للتأكيد أنه بالرغم من الضغوطات لمنع ظهور الحقيقة، لن ينتسى جدّها أبداً.
إسمي محي الدين حشيشو. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
مبارك شلوحي

مبارك شلوحي
اسمي مبارك.
كنتُ مؤهل أول في الأمن العام في سن الستة وثلاثين كما وكنتُ قد عدتُ الى الجامعة من أجل دراسة مادة الحقوق على أمل أن المهارات الجديدة التي قد أكتسبها ستمنحني ترقية في عملي. بسبب ذلك، إضطررتُ الى سلك طريق مجدل (الواقعة في منطقة البترون) كثيراً من أجل متابعة صفوفي في الجامعة اللبنانية الكائنة في منطقة جلّ الديب.
في أحد الأيام وبينما كُنت أستعدُّ للذهاب الى المنزل، طَلَبَتْ صديقتي نجاة إيصال زميلتنا إبتسام بما انها كانت تسكن بالقرب مني.
حلّ الليل ولم نعد. عندها بدأت عائلاتنا بالبحث عنا ووجدوا سيارتي التيوتا الزرقاء مهجورة في منطقة قريبة من منطقة رأس نحاش. ولكن كنا قد اختفينا وزرعنا مع اختفائنا الشكّ في قلوب عائلاتنا والذين حُرموا من أية معلومات عن مصيرنا.
لكن بعد مرور بضعة أيام على اختفائنا، طُلبت صديقتنا نجاة للإستجوب في كفر حزير. هناك، لم يستجوبوها ولكن حققوا معها لمعرفة ا إن كانت هي التي كتبت الرسالة الساخرة عن السوريين. وبالفعل، كانت هي التي كتبت الرسالة الى شقيقة إبتسام ساخرةً فيها عن السوريين من حمص والتي تتضمن فيها نكات كانت تتردد عادةً في المنطقة. هذه الرسالة كانت بحوزة إبتسام في اليوم الذي فُقدنا به إذ طلبت نجاة منها إيصالها الى شقيقتها التي كانت تقطن هناك. كان هدف هؤلاء الجنود السوريين هو تهديد نجاة ولإبلاغها بأنها كانت المسؤولة عن إختفائنا. تم إطلاق سراح نجاة بعد ساعاتٍ قليلة ولكن أسئلتها حول مصير أصدقائها لا تزال دون أجوبة.
اسمي مبارك شلوحي. فُقدتُ أنا وإبتسام. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
كمال حسون

كمال حسون
إسمي كمال وكأي رجلٍ يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً كنت مثابراً في عملي ولا سيما لأنني كنت مسؤلاً عن صيانة الآلات في شركة سنجر. أحببت عملي مما زاد من اجتهادي فيه. ولكن لم يكن هذا السبب الوحيد الذي جعلني مثابراً فيه. إذ إحدى الأشياء التي كانت عزيزة على قلبي ومهمة لي هي تأمين حياةً ودراسةً جيدة لأولادي الأربعة. وكنت اشتري لهم ثياباً أنيقة في كل عيد وكل مناسبة. أحببت رؤية الإبتسامة على وجوههم حين يتلقون تلك الملابس والهدايا.
ولكن كانت ستتبدل حياتي وحياة أولادي بشكلٍ مفاجئٍ في كانون الثاني عام ١٩٧٦.
في إحدى الأيام، ذهبت مع ابنتي إلى السوبر ماركت القريبة من منزلنا في السبتيه لابتياع بعد الحاجات وعدنا إلى المنزل. ولكن عند وصولنا إلى المنزل لاحظت بأنني قد نسيت شراء بعض الشاي. لذلك عدت إلى المتجر ولكن هذه المرة بدون إصطحاب أحدٍ معي.
كانت تلك المرة الأخيرة التي رآني فيها أولادي. كانوا صغاراً جداً. كانت ابنتي البكر لا تتخطى الخامسة من عمرها. تلحقها سونيا التي كانت تبلغ الرابعة من عمرها وثم فاتن ذات السنة وفادي الذي ما زال عمره خمسة عشر يوماً فقط.
بعد اختفائي، اضطرت عائلتي إلى الإنتقال من المنزل الذي كنا نعيش فيه وذلك لأن لم تستطيع زوجتي دفع الإيجار بدون مدخولي. واضطرت إلى البحث عن العمل والسعي وراء وظائف عدة لإعالة العائلة.
عندما تدهور الوضع في لبنان، قررت الهجرة لحماية اولادنا من أي أذى. وقدمت للحصول على جوازات سفر. ولكن السلطات رفضت طلبها مدعيةً بأن تلك الإجراءت تتطلب حضور الأب. حاولت أن تشرح لهم بأن الوالد قد "فقد" وبالتالي من المستحيل أن يحضر. ولكنهم لم يصغوا لها. وعرضوا عليها حلاً وهو بأن تعلن وفاتي.
بالإضافة إلى المعانات النفسية التي نشأت من خلال عدم معرفة مصيري، كان هنالك قيود مالية وإدارية وقانونية. وكانت شجاعة زوجتي هي التي مكنتها من مواجهة كل تلك المواقف، بينما كانت تربي أربعة أولاد.
لكن إضطرت الكثير من الزوجات والأمهات من مواجهة نفس الصعوبات. يحاربون لمعرفة مصير أزواجهن. إضطروا إلى إعالة أسرهن وضمان أطفالهن رغم كل الصعبات - طفولة طبيعية. كلهم ضحايا منسيين لحربٍ مروعة.
إسمي كمال حسون. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
فضيلة و نوري ابراهيم

فضيلة و نوري ابراهيم
هذه الصورة القديمة لفتاةٍ صغيرة محاطة بوالديها هي أكثر بكثير من مجرد صورة بسيطة من الماضي. هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي بقيت من ماضينا.
نيسان عام ١٩٧٥. كانت قد بدأت الحرب لتوّها. كنا في منزلنا في المنصورية مع اولادنا؛ ناريمان، الفتاة الصغيرة في هذه الصورة وسفيان الذي ولد بعد سنة. وفجأةً، إقتحم رجالٌ مسلحون منزلنا وأخذوني أنا وزوجي.
بقيت نريمان التي كانت تبلغ سنة من عمرها وأخاها سفيان الذي لا يتعد الأربعة أشهر في المنزل مع شقيقة زوجي الصغرى حنيفة التي كانت تسكن معنا في ذلك الحين والتي تبلغ من العمر الخامسة عشر سنة فقط.
ظلّ كل منهم محتجزون في المنزل لمدة أربعة أيام، خائفين من عودة هؤلاء الرجال. حتى اليوم الذي أدرك فيه بعض الجيران المأساة التي وقعت. وقاموا بالمساعدة في إعادة شمل الأولاد مع أجدادهم الذين كانوا يسكنون في منطقة عفرين في سوريا.
مضى على إختفائنا حوالي أربعين عام. ولكن لا يمرّ يوماً ولا تفكر إبنتي نريمان بنا. ولأنها كانت طفلة ولا تتذكرنا، تقوم بجمع جميع الذكريات التي يتملكها اقربائنا ورسمها كصورة لتوريثها لأولادها. فقد قالت لهم بأن جدتهم كانت أم حنونة وخياطة ماهرة. وقالت أن جدهم كان نجاراً والذي بالرغم من شخصيته الجدية كان أباً حنوناٌ. تلك الصورة غير كاملة ولكن ذلك ليس مهماً على الإطلاق. ما هو مهم بالنسبة لنريمان هو معرفة مصير والديها وما حدث لهما بعد مجيء هؤلاء المسلحين الى منزلهم.
قصتنا لا تنتهي هناك.
اسمي فضيلة ابراهيم وزوجي هو نوري.
فادي حبال

فادي حبال
إسمي فادي وفي عام 1983 كنت ادرس في معهد العاملية في بيروت. اعتدت الرجوع إلى المنزل في نهاية كل أسبوع للإطمئنان على عائلتي. كنت متطوعاً في الصليب الأحمر مثل العديد من اصدقائي. في تلك الأيام المليئة بالحرب، كنت واثقاً بأن لدي واجباً بمساعدة الآخرين. أعتقد انني ورثت ذلك الإلتزام من والدتي التي كانت تعمل كممرضة.
خلال أيامي القليلة والأخيرة في المنزل، كنت اتحدث مع أختي زينة كثيراً حيث كنت اشركها قصص عمليات الإنقاذ التي شاركت بها مؤخراً. كنت أحزن وأتلهف على فقدان الشبان – الذين كنتُ بعمرهم حينها – للموت بسبب الحرب. لم أكن أتخيل أنه بعد بضعة أيامٍ قليلة سوف أكون أن أيضاً أحد الأشخاص الذين أخذوا بعيداً عن عائلتهم.
في الأسبوع التالي، كان أهلي ينتظرون عودتي كالعادة ولكن لم أتمكن من العودة. وبالتالي، سيطر القلق عليهم فتوجهوا من صيدا إلى بيروت ليسألوا اصدقائي وزملائي في المعهد إن كان لديهم أي معلومات عن مكان تواجدي. ولكن هم أيضاً لم يعرفوا شيئاً عني إذ مرت أيامٍ عدة ولم يسمعوا عني أي خبر.
وفي الأشهر العديدة التي تبعت، قامت عائلتي يائسةً بالبحث عني سائلةً مُختلف الأحزاب التي كانت تتحارب في ذلك الحين ولكن دون الحصول على أي إجابة، إلى أن أتى اليوم الذي جاء فيه شخصاً إلى عتبة المنزل وقال لهم بأنه قد رآني سجيناً في إحدى السجون السورية.
في تلك اللحظة، اطمأنت عائلتي وعرفت انني ما زلت على قيد الحياة. وتولد بداخلهم بصيص من الأمل؛ أمل عودتي إلى المنزل مرةً أخرى. ولكن مع مرور الوقت، عاد اليأس ليسيطر على أحبائي شيئاً فشيئا.
وفي عام 2005 وبينما كانوا يزورون خيمة المفقودين في وسط المدينة، تعرف بضعة أشخاص الذين قد أُطلق سراحهم من سجون سورية على صورتي.
ومرة ثانية، تجدد الأمل بداخل اقربائي ولكن كيف لهم أن يتأكدوا من ما قيل لهم؟ كيف يمكنهم العثور على الأجوبة؟ والأهم، كيف يمكنهم الاستمرار في العيش مع كل تلك الأسئلة التي لا تنتهي؟
إسمي فادي حبال. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
عبد و علي حمادي
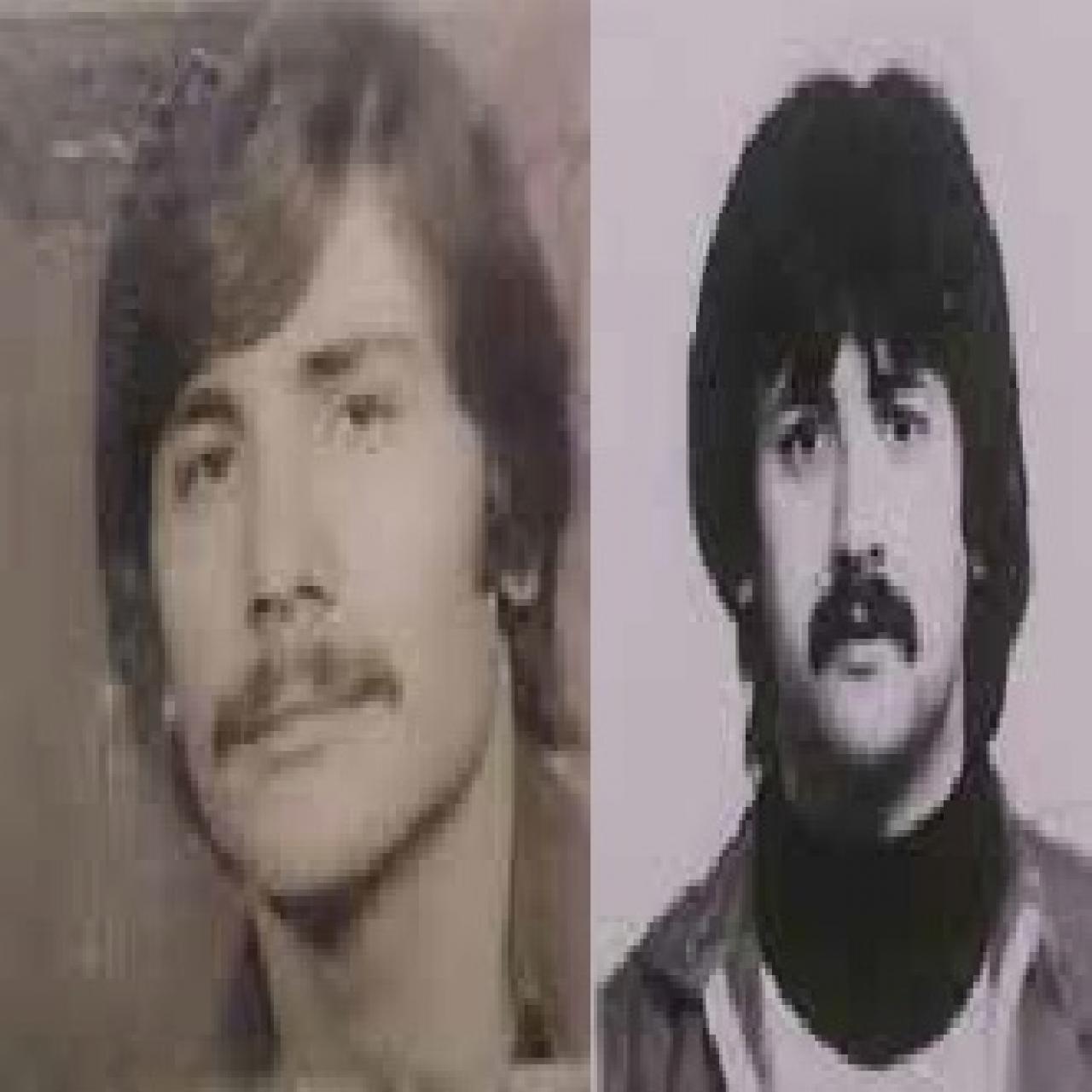
عبد و علي حمادي
إسمي عبد. كنتُ أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً وكنتُ قد حصلتُ على شهادتي في الهندسة الميكانيكية من جامعة في الإتحاد السوفياتي سابقاً حيث كنت قد درستُ.
في اليوم الذي فُقدتُ به، كنت أجلسُ أمام المنزل. اشربُ فنجان قهوة واستمتع بدفء الشمس الخريفية. لقد عدتُ إلى لبنان منذُ بضعةِ أيامٍ وكنتُ أتسائلُ عن مستقبلي في لبنان وإحتمال الهجرة مجدداً بدافعِ إيجاد العمل.
كان المنزل هادئاً. إذ كانت عائلتي تقضي فصل الشتاء في منطقة القماطية.
فجأة، إندفعَ مسلحون الى أمام منزلي. وطلبوا أخي علي. سألتهم من قبل من كانوا وما الذي يريدون منه. ولكن انتابهم الغضب وأخذوني أنا وأخي.
وبينما كانت تتملكني الصدمة، لاحظتُ في تلك اللحظة أن كلّ تلك السنوات المليئة بالعنف والجرائم التي كنتُ محمياً منها عندما كنتُ خارج البلاد، جعلت إختطاف الناس شيئاً سهلاً حتى ولو كان ذلك في منتصف النهار ودون الحاجة إلى تغطية الوجوه.
قالوا الجيران لأحبائنا بأن كان هناك سيارة من نوع مازدا، حمراء اللون تحوم حول المنزل قبيل اختطفنا.
علمت عائلتي فيما بعد بأننا كنا جزء من المجموعة التي تم اختطفها وقتلها إنتقاماً من مقتل الرئيس الذي اغتيل مؤخراً.
واليوم، ما زالت عائلتي تعيش في ذلك المنزل الذي أُخذنا منه. وغالباً ما تقف والدتي على الباب، تنظر نحو الطريق. تتساءل إن كان وجودها في المنزل قد مكّنها من إيقاف الإختطاف.
إسمي عبد حمادي وأخي هو علي حمادي، لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
علي أحمد محمد

علي أحمد محمد
الجمعة 12 أيلول، 1982 كان يوماً عادياً. كنت نائماً في منزلي في منطقة بئر حسن مع زوجتي وأولادي.
في وقتٍ مبكر من صباح ذلك اليوم، استيقظنا على أصواتٍ مدويةٍ قادمة من الشارع. سمعنا أناساً يصرخون في مكبرات الصوت قائلين: "استسلموا وستكونوا آمنين! نحن الجيش اللبناني."
حافظنا على هدوئنا وبقينا مجتمعين سويّاً في المنزل، إلى أن طرق أحدهم بشدّة على الباب. عندها توجهت نحو الباب وفتحته. كان هناك عدّة أشخاص مسلّحين- وكان من الواضح أنهم ليسوا جنوداً لبنانيين. قالوا لنا علينا إخلاء منزلنا والنزول إلى الشارع كي يتمكنوا من تفتيشه.
في الشارع، قُسّمنا إلى مجموعتين: النساء والأولاد في ناحية، والرجال والصبيان- الذين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة وما فوق- في ناحية أخرى. كنا حوالي خمسة وعشرون رجلا. أمرونا بالوقوف جنب الحائط. كنت مع ثلاثة من أبنائي: وليد (18 عاماً) عدنان (15 عاماً) ومحمد (13 عاماً)- كانوا جميعاً مذعورين.
أما النساء والأطفال، فقد نُقلوا جميعاً إلى الملعب الرياضي. أذكر رؤية زوجتي وهي متمسكة بإحكام بأيدي أولادنا الأصغر سنّا بينما كانت تنظر خلفها إلينا وهي تمشي بعيداً.
لم يجتمع شملنا مجدداً. لاحقاً في ذلك اليوم، عاد ابني البكر حسين من عمله إلى المنزل ليجده فارغاً. خرج للبحث عنا ولكن أثناء محاولته تلك، ترجّل مسلحون من سيارتهم وأخذوه.
هل كنا ضحايا عمل إنتقام فردي أو ضحايا عملية عسكرية واسعة؟
لقد فُقدتُ مع أربعة من أبنائي. كم شخصاً آخراً واجه نفس المصير في ذلك اليوم؟
اسمي علي. أولادي هم وليد، عدنان، محمد، وحسين.
لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
عصام فيتروني

عصام فيتروني
اسمي عصام وكنتُ أُحب العمل بيديّ. أحببتُ مساعدة والدتي في الإعتناء بالحديقة. كنتُ معروفاً بكوني شخصاً خدوماً الذي دوماً ما كان مندفعاً للمساعدة وهو الأمر الذي أدّى الى فقداني.
كنا في عام 1982، خلال إجتياح إسرائيل وكان قد مرض طفل صديقي وكان بحاجة ماسّة للذهاب الى الطبيب. فعرضتُ عليه أن أقله الى عيادة الطبيب في سوق الغرب رغم كل التحذيرات التي سمعتها. فأوصلته وزوجته وطفله الى هناك وكنتُ في طريقي عائداً الى منطقة عاليه، عندما تم إيقافي من قبل حاجز طيار. كانت تلك الحادثة آخر معلومة عني.
كان هناك إطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد أحد قبل ثلاثين دقيقة من مروري. الأمر الذي أدّى الى إقامة حاجز عفوي. كان قدري ان امرّ من هناك. عندما لم أعد الى المنزل عند الساعة السادسة مساءاً، بدأت عائلتي بالقلق وبدأوا بالبحث عني. قال لهم أفراد من قريتنا بأنهم قد رأوني جالساً في المقعد الخلفي من سيارتي مع أربعة رجال غربيين وواحداً منهم كلن يقودُ سيارتي بسرعة فائقة. لم أُر منذ ذلك الحين. منذ تلك الحادثة، أبقت والدتي ثيابي في خزانتي كما هي، إذ لا تزال تنتظر عودتي الى المنزل.
اسمي عصام فيتروني. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
صبحي رميض

صبحي رميض
اسمي صبحي. تركتُ مدينة صور، مصقط رأسي، للسكن في بيروت مع زوجتي حسنية. كنا سعداء لبدأ حياة جديدة سوياً وكنا متشوقان للترحيب بطفلنا الذي كان سيولد بعد بضعة أسابيع فقط.
ليلة اختطافي، كنتُ في منزلي مع ابن عمي مرعي. أما حسنية، فكانت تزور شقيقتها في منطقة الحمرا، فقد كان قد اقترب موعد الولادة لذلك وجود شقيقتها بقربها طمأنها. اما ابن عمي، فقد ترك صور في الصباح الباكر وأتى لزيارتنا وامضاء الليلة لدينا، اذ كان ينوي السفر في اليوم التالي الى المانيا بهدف لقاء طبيب عيون، فهو خسر بصره جراء حادثة حصلت معه أتلفت فيها شبكة عينه.
كنتُ مسروراً جداً برؤيته. فعلى الرغم من اختلاف شخصياتنا، كنا مقربيْن كثيراً من بعضنا البعض كوننا كنا قد نشأنا سوياً. كان مرعي شخصاً ذو جسدٍ طويلٍ عارمٍ ولكن كان طبعه خجولاً متحفظاً. أما أنا، فكنتُ قصير القامة ولكن ذو شخصية منفتحة. أحببتُ الحفلات، وخصوصاً حفلات الزفاف حيث كنتُ أرقص الدبكة دوماً. لكن بدلاً من أن تكون سباباَ لتفريقنا، كانت خِلافاتنا مصدر توافقنا. في تلك الليلة وبينما كنا على الكنبة نتحدث، دخلت علينا فجأةً مجموعة من الرجال وقامت باخذنا.
كنتُ في السابعة عشر من عمري. أما مرعي، فقد كان في التاسعة عشر.
تبقى بقية قصتنا غير معروفة أو على الأقل تفاصيل اختطافنا.
لكن قصة سلام هي القصة التي كُتبت من دوني. فقد ولدت ابنتي الصغيرة بعد اختطافي ببضعة أيام فقط.
اسمي صبحي رميض وابن عمي هو مرعي رميض. لاتدعوا قصتنا تنتهي هنا.
شاهين عماد

شاهين عماد
في ذلك اليوم وفي الصباح الباكر، غادرنا قرية الأزونيه في عاليه واتجهنا إلى بيروت. ذهب كل من فريد وأيمن معي. كانا صديقي طفولتي ودوماً ما شاركاني أسعد لحظات حياتي. في ذلك الحين وبينما كنا في السيارة، كنا نتحدّث عن خططنا المستقبلية، ونتخيّل ضاحكين كيف سنبدو بعد مرور عشرين عاماً. لم أكن أعرف كيف سيكون مستقبلي ولم أهتم لأمره كثيراً، إذ كان ذلك اليوم وتلك اللحظة هي الأهمّ في حياتي. كنت سأتزوج بعد بضعة أيام وكان ذلك كل ما يشغل تفكيري وكنت في طريقي إلى دعوة خالي وأقربائي إلى حفل زفافي.
أراد فريد الذهاب في سيارته لإحضار والدته وشقيقاته لقضاء نهاية الأسبوع في القرية. أما أيمن فلم يكن يريد أن يفوت فرصة قضاء بعض الوقت معنا ولذلك قرر مرافقتنا. لم نكن نتوقّع أن تنتهي رحلتنا الممتعة بطريقة مأساوية، إذ لم نتجاوز حاجز بحمدون.
في ذلك الوقت، كان شقيق فريد، غالب، رئيس مركز الشرطة في برج حمود. حاول كثيراً أن يعثر علينا، ولكنّه لم يجد سوى سيارة شقيقه مهجورة في بيروت بالقرب من مركز اعتقال تابع لإحدى الميليشيات التي كانت تقاتل في الحرب.وعلى الرغم من كل محاولاته، لم تعرف أسرنا حتّى الآن حقيقة ما جرى لنا.
لقد فقدنا صباح يومٍ من شهر حزيران عام 1982، قبل أيام قليلة من حفل زفافي.
اسمي شاهين عماد وأصدقائي هم فريد كوكش وأيمن سليم. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا
سليم إسماعيل

سليم إسماعيل
اسمي سليم.
بعد أن أمضيت 3 سنوات في العمل خارج البلاد، عدت إلى لبنان لأتزوج وأؤسس عائلة. كنت أعرف هدى منذ صغرنا إذ كنا جيران.
كان لدينا طفلة صغيرة، رنا. كنت معتاداأن أعد لها زجاجة الحليب قبل ذهابي إلى عملي في ورشة البناء. أما في عطلة نهاية الأسبوع، فكنا نذهب للتنزه في الطبيعة حيث كنت أكرس نفسي لشغفي: التصوير الفوتوغرافي. كان من الواضح أن رنا هي شخصيتي المفضلة للتصوير.
في عام 1982 إستقبلنا طفلنا الثاني: محمد. بعد ولادته، إنتقلنا لبعض الوقت إلى منزل عائلة زوجتي هدى الذين قدموا لنا المساعدة في رعاية الطفلين. معرفة أنها والأطفال في أمان طمأنني لأنه منذ اغتيال الرئيس بشير جميل، أصبح الوضع في صيدا متوتر جداً.
و بعد شهر واحد فقط، في 22 تشرين الأول 1982، أتى رجال مسلحين إلى ورشة البناء حيث كنت متواجداً مع العمال الآخرين. أخذوني أنا وصديقي أحمد، الذي كان فلسطينياً أيضا وتمَ نقلنا إلى مركز الإحتجاز في منطقة الرميلة التي تقع خارج صيدا حيث تم استجوابنا. آخر ما علمته عائلتانا هو أننا نقلنا إلى الجية.
كالعديد من زوجات المفقودين، تركت هدى وحدها لتربية طفلينا الصغيرين. وبينما كانت تكافح لتجدني، كانت تحاول أيضاً أن لا تدع حزنها يؤثر على طفلينا وأن تستمر بتوفيرحياة سعيدة لهم كما كانت الحال من قبل.
ولكن في كلِ ليلة، عندما كان الأولاد يأوون إلى الفراش، كان الصمت المخيف يسيطرعلى المنزل. كان غيابي وعدم يقينها بمكان يعذبانها.
اسمي سليم إسماعيل. وإسم صديقي أحمد. لا تدعوا قصصتنا تنتهي هنا.
سلوى الشيخ محمد

سلوى الشيخ محمد
اسمي سلوى. كنت فتاة مرحة مفعمة بالنشاط، و دوما على استعداد لتقديم المساعدة. بعد المدرسة، كنت أعود إلى البيت للمشاركة بالأعمال المنزلية، إذ كنت الأخت الكبرى لثمانية إخوة.
كنت متطوّعة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني، أذهب إليهم في وقت فراغي لتقديم العون.
كنت أبلغ ستة عشر عاما. في ذلك الحين، كانت حياتي وأحلامي تشبه حياة وأحلام أي فتاة في ذلك العمر.
لكن في ربيع عام 1976 وبينما كنت أستعدّ لعطلة الموسم، اندلعت معارك عنيفة في حيّنا، إذ بدأ الحصار على مخيّم تلّ الزعتر. أدّى هذا الحصار إلى جعل العديد من الناس محتجزين كرهائن داخل منازلهم ومن ضمنهم عائلتي. دامت المعارك أربعة وخمسون يوماً، نتج عنها المئات من الضحايا. كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر شاهدةً على ذلك بينما كانت تحاول إخراج الجرحى من المخيم.
لكن في 12 آب عام 1976، والمعروف بيوم سقوط المخيم، حاول الآلاف من المدنيين الفرار إلاّ أنّ العديد منهم لم يصلوا إلى برّ الأمان، مثلي تماماً.
إنّني واحدة من العديد من النساء اللواتي فُقدن خلال الحرب الأهليّة اللبنانية، واللواتي لا زال مصيرهنّ غير معروف.
فُقدت كل من زكيّة وسميرة وماري كريستين وكريمان وهنريت وغيرهنّ في تلّ الزعتر وصيدا وغرب بيروت والدامور وعاليه وطرابلس…
أياً كان السبب الذي أدّى إلى فقداننا، وأياً كانت هويّة المسؤولين عن تلك الأفعال، لا تدعوا قصصنا تقع في طيّ النسيان. لا تدعوا قصصنا تنتهي هنا.
ريّا دواري

ريّا دواري
اسمي ريّا وكنتُ أماً شابة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً. بعد أن كنتُ قد فقدتُ زوجي، اضطررتُ منذ حينها تربية إبنتي عبير ونسرين بمفردي. وبعد مرور فترة من البأس، استعدتُ قوتي واستقريتُ في وظيفة. كنتُ مسؤولةً عن تنظيم قدوم ومغادرة الشباب والشابات الذين يسعون الى متابعة دراستهم خارج البلاد. كنتُ مسرورةً جداً بالمساهمة في ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأفراد. وبين تقسيم وقتي ما بين تربية أولادي ومتابعة عملي، كان من الصعب جداً أن أخصص وقتاً لنفسي. لذلك، كنتُ أنتظر بفارغ الصبر عودة بناتي الى المدرسة من أجل إستعادة أنفاسي.
حين أُختطفتُ، كنتُ في طريقي الى سوق الغرب لتسجيل عبير ونسرين في المدرسة. فلقد كنتُ مع أربعة ركاب آخرين حين تم إيقافنا على حاجز بالقرب من منطقة المتحف في بيروت. كانت سامية ومنى وحنان ويونس طلاب شباب متجهين الى سوريا. كان من المفترض أن يكونوا على متن طائرة متجهة الى موسكو حيث كانوا يتعلمون. عوضاً عن ذلك، فُقدنا جميعاً. تم إطلاق سراح السائق فقط الذي قام باخبار عائلتي بالخبر المشؤوم.
كان عمر كل من عبير ونسرين خمسة وستة سنوات فقط. من بعد ذلك، اضطرتا الذهاب الى المدرسة دون وجود والدتيهما. في البداية، كانت آلامهما لا تطاق ولكن مع مرور الوقت خفّ ذلك الألم. لكن لا زال عيد الأم يوماً مؤلماً جداً لهما.
اسمي ريّا دواري. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
ديب مطر

ديب مطر
إسمي ديب وكنت أقيمُ مع زوجتي وأولادي في الأوزاعي. كنتُ رجلاً لم يشارك بالحرب بتاتاً يبلغ من العمر واحد وأربعين عاماً. وكنتُ أبذلُ قصارى جهدي لإبعاد ولديّ عن تلك المليشيات.
اشتقت الى الأيام التي كنا باستطاعتنا الذهاب الى أي مكان بحُرية. اشتقت الى الأوقات عندما لم يكن للطوائف الدينية أي تأثير على العلاقات الصداقية. دوماً ما كنتُ أتمنى نهاية كل تلك النزاعات.
ولكن لسوء الحظ، لم تسنح لي الفرصة برؤية نهاية كل تلك المعارك.
وفي 7 تشرين الثاني عام 1985 وبينما كنت أُغادر مكان عملي رآني احد زملائي ، في شراكة جنود سوريين جالساً في المقعد الأمامي في سياراتي. ناداني للتأكد من أن كل شيءٍ على ما يرام. فقلت له بأنني سوف أوصل هؤلاء الأشخاص الى الهرمل وسأعود بعد ذلك الى المنزل مباشرةً.
كانت تلك الكلمات هي الكلمات الأخيرة أي شخص سمعها مني.
أقسمت زوجتي فاطمة على ايجادي بعد ذلك. إذ طرقت على كل باب، إن كان في لبنان أو في سوريا. "تعي بكرا!". كان هذا الجواب الوحيد والمختصر الذي تلقته. ولكن كان هذا هو الجواب الوحيد الذي رفع من آمالها في ذلك الحين، حتى ولو كان لبضعة ساعات. آمال مساعدة أي شخصٍ لها. ولكن عندما كانت تعود في اليوم الثاني، كانت تستنتج بأن ذلك الجواب هو للتخلص منها وأن تلك الأشخاص كانت تتجنب أسئلتها الساحقة.
ولكنها لم تستسلم. وبقيت تحارب العالم؛بينما كانت تشدد بأن لا يمكن لزوجها أن يختفي هكذا ببساطة وتناشد للمساعدة.
والطريقة الوحيدة التي وجدت فيها المواسات هي من خلال تمضية الوقت مع زوجات وأمهات المفقودين. هؤلاء الناس الذين فصلتهم الحرب عن أحبائهم. أناس من مختلف المناطق والطوائف، أتو لمشاركة أحزانهم والمطالبة بالإفراج عن أحبائهم.
انتهت الحرب ومعاركها ولكن معاركهم مستمرة.
إسمي ديب مطر.وما زالت زوجتي فاطمة تنتظر مثل الآلاف من النساء في لبنان . لا تدعوا قصننا تنتهي هنا.
داني منصوراتي

داني منصوراتي
عام 1990، هذا التاريخ يُمثل نهاية الحرب الأهلية اللبنانية ونهاية التفجيرات وعودة الوِئَام. بعد مرور خمسة عشر عاماً على بداية هذا الصراع الطويل، قرر أُمراء الحرب والسلطات الأجنبية وضع حدّ لهذه الحرب و"طيّ الصفحة" والتغاضي عن الفظائع التي أُرتكبت خلالها.
عام 1993، بدأت عملية "إعادة البناء" وبدأت الحياة تستعيد توازنها شيئاً فشيئا. ولكن بالرغم من كل الجهود التي طُرحت لإسكات معاناة الضحايا، لا زالت صرخات أهالي المفقودين اليائسة تصدوا.
خلال ذلك العام، كُنتُ في دمشق مع شقيقي بيار، وكنا في طريقنا لزيارة أقاربنا. فجأةً، أوقفنا أعضاء من النظام وأجبروا شقيقي على النزول من السيارة وصعدوا الى سيارتي. في غضون ثوانٍ قليلة، أُختطفتُ في قلب دمشق وفي وَضَحِ النهار وتُم نقلي الى سجن صيدنايا الذي يقع على بعد ثلاثين كيلومتر جنوب المدينة والذي كان معروفاً بقسوتهِ. لم يُفرج عني أبداً.
في 11 نيسان عام 2005، بدأ أهالي المفقودين بالإعتصام للفت الإنتباه الى مأساة المعتقليين اللبنانيين في سوريا. وفي سياق تلك الحقبة، كانت تلك الإعتصامات عملاً شجاعاً ورمزاً لأملاً حقيقياً. وكانت والدتي قد إنضمت الى عشرات النساء الذين تجمعوا للمطالبة بحرية أحبائهم. ولكن إنسحاب الجيش السوري لم يُنهي معاناتهم وكان على عكس ما يتوقعونه. والخيمة التي أُنشأت بهدف الإستغاثة، للأسف أصبحت جزء من مناظر وسط المدينة والآن تفشل في جذب أي إنتباه.
عام 2017، ما زالت الخيمة هناك ولكن تعرّت من أولئك الذين أعطوها الحياة. هؤلاء النساء الذين إعتصموا خلال السنوات الإثني عشر الماضية، كبِروا وحُرموا من أولئك الذين قدموا لهم الدعم المستمر وفقدوا القدرة على الإستمرار. لقد تم التخلي عنهم لمواجهة مصيرهم ولكن لن تتخيب أمالهم بأن يُسمعوا.
أمضت والدتي معظم وقتها في المنزل تهتم بغرفتي وتتأكد بأنها ما زالت كما تركتها. لم تقفّ عن القول بأن من أسوأ الآلام التي يمكن أن تُلحقه بأي والدة هو معرفة معاناة ولدها وعدم القدرة على مساعدتِه.
إسمي داني منصوراتي. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
خليل منشاوي

خليل منشاوي
إسمي خليل. قبل بدء الحرب، كنت أعيش في منطقة الدكوانة مع زوجتي وأولادي الخمسة. كنت أعمل كمحاسب في محطّة للوقود قرب منزلنا. أحببت عملي كثيراّ.
لسوء الحظّ، كان التّوتّر في المنطقة في تزايد مستمرّ. عرفت بأنّه لا يمكننا البقاء في هذا البلد لمدّة طويلة، لذلك كنت أقوم بالترتيبات اللاّزمة للانتقال مع عائلتي إلى ألمانيا.
إلاّ أنّ الوضع الأمني تدهور بسرعة، وفي 12 آب من العام 1976، لجأ المسلّحون إلى الجبال وتمّ إجلاء المدنييّن إلى بيروت الغربية. كلّ شيء كان في حالة من الفوضى. كنّا مع آلاف الأشخاص الّذين كانوا يحاولون الصّعود إلى القافلات للابتعاد عن الخطر. ولكن لسوء الحظّ، لم تكن هناك قافلات كافية لنقل الجميع، فاضطررنا أن نحشر أنفسنا بإحكام شديد داخلها. كانت زوجتي تمام تحمل ابنتنا سيلفانا ذات الستّة أشهر بين ذراعيها. وتمسّك أولادنا الأربعة، والّذين تراوحت أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات، بينما كنت أحاول البقاء متماسكاّ في ظلّ تلك الجلبة. إلاّ أنّ مزيداً من النّاس استمرّوا بالصعود إلى القافلة، لدرجة أنّنا لم نعد قادرين على التنفّس. في ذلك اليوم، مات العديد من الأطفال اختناقاً ومن بينهم كان ابني وسام البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابنتي سوسن الّتي كانت في سنّ الخامسة حينها.
لقد كان من المتوقّع أن ينتهي كابوسنا عند منطقة المتحف. كان هناك حاجز تفتيش واحد قبل أن نصل إلى بيروت الغربية. ولكن عندما وصلنا إلى هناك، أمرنا رجال مسلّحون بالخروج من القافلة، ووضعوا الرجال إلى جهة والنّساء والأطفال لجهة ثانية.
إسمي خليل منشاوي. لا تدعوا قصّتي تنتهي هنا.
خليل أبو زكي

خليل أبو زكي
تُم تحديد كل شيء؛ جوازات سفرنا مع تذاكر الطياران. بعد يومين سنكون في إلمانيا لبدأ فصل جديد في حياتنا. كان الأولاد متحمسون كثيراً...
ولكن قبل مغادرتنا، وجب عليّ الذهاب الى سوريا لتسلّم بضع من قطع شاحنات بناءاً على طلب من الشركة التي كُنتُ أعمل بها. خططتُ للذهاب الى ميناء اللاديقية يوم السبت والعودة الى المنزل يوم الأحد.
ولكنني لم أعد، حتى عندما حان وقت ذهابنا الى المطار صباح يوم الإثنين. عندها ساد القلق على وجوه أقربائي. كان واضحاً لهم بأن السبب الوحيد الذي يُمكن أن يجعلني أُفوت رحلة سفري الى إلمانيا هو إذا حصل شيئاً سيئاً لي.
كان واضحاً بأنني قد دخلتُ الى الأراضي السورية من خلال سجلات الدخول على الحدود إذ كان هذا الأثر الوحيد الذي بقي لي.
وفي 13 حزيران من عام 1987، إنهارت حياتي وحياة عائلتي في مكانٍ ما في سوريا.
إذ بعد إختفائي، فقدت زوجتي دلال الأمل بالكامل. وبسسب الحزن الشديد، فقدت القوة على الإستمرار وشعرت بأنها غير قادرة على تربية ثلاثة أولاد لوحدها. وبعد سبعة أشهر من ذلك اليوم المأساوي، غادرت وتركت كل من عبير، إبنتي البكر والتي كانت تبلغ من العمر تسعة سنوات ومنال التي كانت تبلغ من العمر ثمانية سنوات وبهاء الذي لم يتعدّ الخمس سنوات، ليتم رعايتهم من قبل أجدادهم.
مع مرور الوقت، إعتاد أولادي على العيش في غيابي وبدأوا بتأسيس حياة خاصة بهم. ولكن حتي الآن، ما زالت إبنتي البكر عبير تعيش في الذنب؛ تدين حياتها المريحة المليئة بالضحك والحياة بفكرة إمكانية وجود والدها خلف قضبان السجن، حياً. وتحلم بايجادي والقول لي والدموع في عينيها: "آسفة لأنني خذلتك."
إسمي خليل أبو زكي. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
حسين فنيش

حسين فنيش
إسمي حسين، كنت في السابعة عشر من عمري وكنت أدرس في مدرسة خُضر الثانوية (في بيروت). كنت شاباً طموحاً ومجتهداً أحلم بأن أصبح يوماً ما طبيب أسنان. كنت قد وعدت شقيقتي فاطمة بأنّها ستكون مريضتي الأولى.
ولكنّ الحرب وضعت حدّاً لكلّ أحلامي.
في أحد الأيام من عام 1976، اندلع حريق في حيّنا بالقرب من مكان سكني. اضطررت وعائلتي أن نخلي منزلنا تاركين جميع ممتلكاتنا. انطلقنا أنا ووالدتي زاهية بالسيّارة، متجهين نحو منطقة الأشرفيّة. إلاّ أنّه تمّ توقيفنا على حاجز تفتيش بعد مغادرتنا بدقائق قليلة.
أجبرنا رجالٌ مسلّحون أن نترجّل من السيّارة وقاموا بفصلنا.لحسن الحظّ، تمّ إطلاق سراح أمّي ولكن للأسف لم يحالفني نفس الحظّ.
لقد مضى على تلك الحادثة أربعون عاماً، وحتىّ اليوم لم تسمع عائلتي عني أيّ خبر.
من حوالي عشر سنوات، كانت شقيقتي فاطمة في سيارة أجرة، وظنّت بأنّها رأتني أسير في الشارع. تسارعت دقات قلبها ممتلئة بالأمل، وطلبت من سائق الأجرة أن يرجع قبل أن أغيب عن نظرها. ولكن للأسف، كان مجرّد شخص له نفس لون شعري وتسريحته.
بعد مرور سنوات عدة، تعتقد فاطمة أنني على الأرجح قد توفّيت. ولكنّ قلّة المعلومات حول مصيري، تبقيها وعائلتي في حالة شكّ مستمرّة. ذلك الشّك الذي يجعل من الصعب على جروحهم أن تلتئم. مهما كانت الحقيقة، فإنّ شقيقتي مستعدّة لتقبّلها إذ أنّها بحاجة لأن تعرف.
إسمي حسين… قصتي لا تنتهي هنا.
حسن غندور
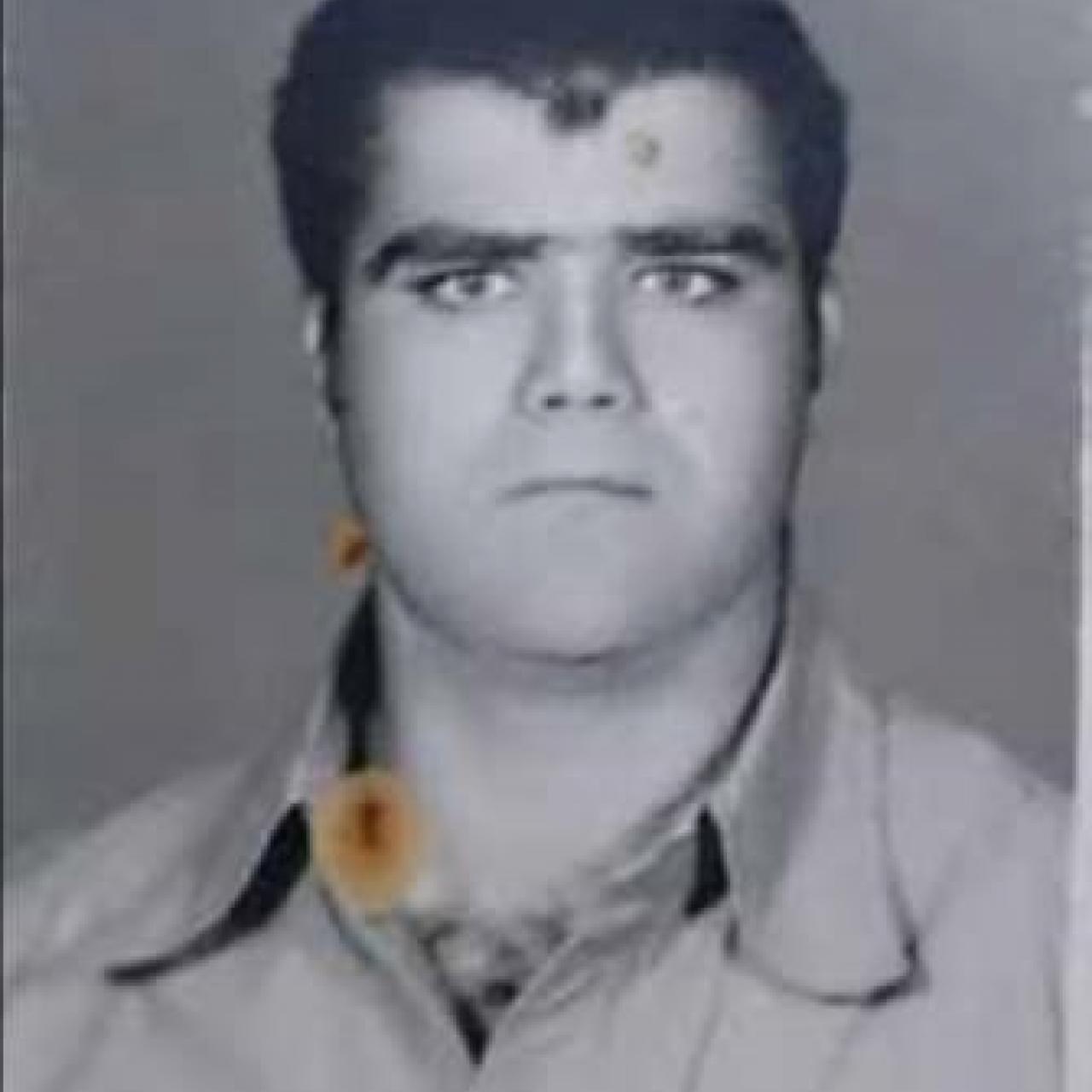
حسن غندور
بيروت، السبت 6 كانون الأول لعام 1975.
تم إعتقال وقتل وإختطاف مئات الأشخاص في غضون ساعتين.
اسمي حسن غندور وأنا أحد ضحايا السبت الأسود.
في ذلك اليوم، كنت أُقيم في فندق في وسط مدينة بيروت بالقرب من ساحة الدباس. لقد الزمني عملي كمحرر في جريدة السفير على المكوث هناك أحياناً. كنتُ استأجر غرفة لمدة يوم أو يوميين عند ضرورة العمل في بيروت إذ كان منزلي في جويّا في الجنوب.
لقد سمعتُ طلقات رصاص في ذلك النهار. لم يبدو كأنه تبادل طلقات ولكن بدى وكأنه آتٍ من مكانٍ واحدٍ. بقي صوتُ تلك الطلقات يعلو أكثر فأكثر. أصاب الذعر كل من حولي وبدأت الناس بالهرب بينما كان الهلع محفور على وجوههم.
وبدأت الأخبار تنتشر حول المجزرة.
توحهتُ الى فندقي وبينما كنتُ أصعد الدرج، سمعتُ احد الرجال المسلحين يسأل موظف الإستقبال عن لائحة أسماء الضيوف. وعندما قالوا إسمي تملكني الخوف وتوقف قلبي عن النبض.
بعد ثوانٍ قليلة، وجدتُ نفسي معصوب العينيْن في سيارة متجهة نحو المجهول؛ مجهولً جعل الإرتياب يتملكني.
ماذا حصل بعد ذلك؟ لا أحد يعلم. هل تم قتلي ودفني على بعد بضعة أمتارٍ قليلة؟ أو هل تم أخذي للإستجواب ومن ثم نقلي الى معتقل بعيد عن مكان إختطافي؟
بعد مرور أربعين عاماً، ما زالت عائلتي تنتظر جواباً.
اسمي حسن غندور. قصتي لا تنتهي هنا.
جوزيف كيروز

جوزيف كيروز
إسمي جوزيف.
كنتُ رقيباً أولاً في الجيش اللبناني لمدة خمسة عشر عاماً، وكنتُ اخدم بلدي بفخر في المدرسة العسكرية في الفياضية. لكن ولسوء الحظ، انقسم الجيش اللبناني في كانون الثاني من عام 1976. فقررتُ حينها أن أترك الجيش لأسبابٍ أخلاقية وأمنية ولكي أبقى بجانب عائلتي وإبني الوحيد إيلي، الذي أنجبناه أخيرا بعد معاناة دامت 14 سنة. كان إيلي يعني كل شيء بالنسبة لي. إلا أن احداً لم يكن يعلم أنه وبعد مرور سنة واحدة فقط على ولادته، اُبعدتُ وانفَصَلتُ عن إبني الوحيد.
في شهر نيسان من عام 1976. وبأننا كنا نعاني من نقصٍ في الوقود في منطقة سن الفيل حيث كنت أقطن، اضطررت الذهاب لشراء البعض منه. وصلت إلى محطة خضر للوقود في منطقة البربير. ملأت سيارتي وعدت إلى منزلي. لسوء الحظ، عندما ذهبتُ للمرة الثاني في الخامس والعشرين من نيسان، لم أكن موفقاً كالمرة السابقة. فلقد تم اختطافي في تلك المنطقة التي باتت تعرف كاحد أخطر مناطق العبور ما بين بيروت الشرقية والغربية.
أما اليوم، فهي عبارة عن مجرد تقاطع سير لا أكثر، دائماً مزدحمة ودوماً ما يعبر العامة دون ادراك ما مدى أهميتها الحاضر منها والماضية.
إسمي جوزيف كيروز. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
جورج شمعون

جورج شمعون
اسمي جورج. كنتُ جندياً شاباً من قرية سرعين في البقاع. كنتُ أتطلع الى إجازتي إذ كنتُ أعود الى منزل وأقضي بعض الوقت مع جوزيف الذي كان أخي وزميلي في الصيد.
خلال شهر تشرين الأول من عام 1975، وفي إحدى تلك الإجازات، أُختطفتُ. كنتُ عائداً الى قريتي مع إثنين من زملائي في الجيش عندما تم إيقافنا على حاجز في شتورة.
منذ ذلك اليوم وعلئلتي لا تعرف شيئاً عن مصيري. لكن في عام 1979، قام ثلاثة لبنانيون بإبلاغ عائلتي بأنهم كانوا محتجزون معي في سجن مزّة. وبعد المرور القليل من الوقت، قدِم شخص آخر وأكدّ لهم بأنني محتجزاً في ذلك السجن. قام ذلك الشخص بوصفي لهم بشكل مفصّل ولكن لم تصدقه عائلتي. ولكن بعد فترة، هرعت والدتي الى ذلك السجن لتعلم بأن تم نقلي الى مستشفى. ذهبت والدتي الى تلك المستشفى وأرتهم صورتي وإذ تعرفت الممرضات علي وأكدوا لها بأنني كنتُ في تلك المستشفى ولكن أوضحوا لها بأنني لم أعد هناك.
تلك هي القصة التي كانت والدتي ترددها مراراً وتكراراً ودوماً ما كانت تقولها بنفس الشدة والمشاعر. كانت تأمل دوماً لو أن قصتي تُسمع من خلال بعض الصحافيين والمنظمات الغير الحكومية الذين أظهروا إهتماماً صادقاً بي وبقصتي. وكانت تتمنى أيضاً بأن لا أبقى واحد من الستة مئة قضية مفقود في سوريا.
واليوم، لم تعد معنا. إستلم أخي جوزيف دور والدتي وما زال ينشر قصتي للعالم لتبقي ذاكرتي حيةً، آملاً بكشف مصيري يوماً ما.
إسمي جورج شمعون. قصتي لا تنتهي هنا.
جرجي حنا

جرجي حنا
في أيلول عام 1985، وتنفيذاً لطلب لجنة الأبحاث التي أنشئت في الجامعة اللبنانية، تم تعليق جميع الصفوف في معظم كلّيات الجامعة لمدة ساعة. إنً هذا العمل الرمزي بالإضافة الى التجمع الذي أقيم في نفس اليوم، كان قد نُظّم لطلب الإفراج عن عدّة أساتذة قد تم خطفهم واعتقالهم وهم: مها حوراني، راجي خوري وجرجي حنا.
إسمي جرجي وكنت أحد الأساتذة المخطوفين. كنت أستاذ هندسة إلكترونية.
لقد أتممت دراستي في ألمانيا بفضل منحة دراسية قدمت لي. حصلت على شهادة دكتوراه كما تعرّفت على زوجتي باربرا. بعد أن كنا قد أمضينا مدة 12 سنة هناك، قررنا العودة إلى لبنان مع ابنتنا دوريس.
كنا نقطن في منطقة جدايل بالقرب من جبيل وكنا نقود السيارة الى بيروت بشكل يومي للذهاب إلى العمل. كانت باربرا تدرّس في معهد العاملية وأنا في كلية العلوم في الحدث. لكن عندما أصبح التنقل خطراً علينا، قررنا أن نستأجر شقّة في ساقية الجنزير. ولكن بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي بيروت، قامت زوجتي وابنتانا بالذهاب إلى منزلنا بالقرب من جبيل لأنه آمن أكثر، وذلك قبيل سفرهنّ إلى ألمانيا لكي تعود ابنتيّ إلى المدرسة بينما يهدأ الوضع الأمني في بيروت.
في العاشر من أيلول عام 1985، أي قبل يومين من عودة عائلتي إلى لبنان، تم اختطافي بينما كنت في طريق العودة إلى البيت من كليّة العلوم التي نقلت مؤقتاً إلى جانب الأونيسكو. لقد أوقفني حاجز مؤلف من عدة رجال مسلحين في منطقة تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان.
بقي مصيري مجهولاً بالنسبة لعائلتي وأقربائي لمدّة تزيد عن 10 سنوات إلى أن تم إطلاق سراح معتقل من السجون السورية والذي قام حينها بالتواصل مع أقربائي وإعلامهم بأننا كنا معتقلين سوياً، وبأنّني كنت قد اعتقلت سنتين في لبنان ومن ثمّ تمّ نقلي إلى سجن المزّة في سوريا.
بعد سماع ذلك الخبر الرهيب، قام أقربائي بالذهاب إلى ذلك السجن. استطاعوا أن يقرأوا إسمي على لائحة التسجيل ولكنهم مُنعوا من مقابلتي. السبب الوحيد لاعتقالي والذي حصلوا عليه هو بأنني مُتهم بالعمالة وأنني قد حُكمت بالمؤبد.
بالرغم من التحرك الذي قامت به عائلتي وأصدقائي وزملائي وتلاميذي، إلا أنه لم يتم قطّ الإفراج عني.
إسمي جرجي حنا. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
اسطفان إسكندر

اسطفان إسكندر
إسمي اسطفان.كنت أعمل في شركة للبلاط في منطقة البترون قبل بداية الحرب. كنت أباً لأحد عشر طفلاً؛ سبعة صبيان وأربعة بنات، تتراوح أعمارهن بين السنة والنصف والواحد والعشرين عاما. كنت فخوراً جداً بأولادي الصّبيان، ولكنّني كنت معروفا بمدى تدليلي لبناتي. إذ كنّ أميراتي، وكان بامكانهنّ أن تسألني عن أيّ شيءٍ تردنه، وكنت دوماً مستعدّاً لمنحهنّ الفرح والسعادة.
كُنّا نقيم في قرية صغيرة في البترون اسمها بجدرفل. كانت قرية جميلة وآمنة ولكن في بداية عام 1975، دخل مسلّحون الى قريتنا وأسّسوا لأنفسهم معسكراً فيها. بعد دخولهم القرية، نزح العديد من القرويّين منها خاصّة الشباب. طلبت من زوجتي بهيّة الذهاب مع أولادنا الى جبيل بهدف إبعادهم عن أي خطر. أما أنا، فقد بقيت في القرية بسبب عملي. بعد فترة قصيرة، استقرّ الوضع في المنطقة وطلبت منهم العودة إلى المنزل.
لكن في شهر آب من عام 1975، وبعد ثلاثة أشهر من بداية الحرب، طرق الرّجال المسلّحون الذين كانوا قد مكثوا في قريتي باب منزلي، وأجبروني على الخروج منه. كلّ ذلك حصل أمام أعين أولادي وزوجتي.
لم تطأ قدمي ذلك المنزل منذ ذلك الحين. أُجبر أفراد عائلتي على مواجهة الحرب وخمسة عشر عاماً من المشقّة وحدهم. لم أكن هناك لأمنحهم الحياة الكريمة، ولا لطمأنة أولادي عندما كانوا خائفين من صوت التفجيرات، ولا هناك لكي أمنح زوجتي القوّة في لحظات الرّيبة والحيرة. لن تستطع بهيّة أن تعرف مصيري أبداً، فقد توفّيت قبل سنوات قليلة. أمّا أولادي، فما زالوا يأملون بمعرفة ما حصل في ذلك اليوم المشئوم من شهر آب من عام 1975.
إسمي اسطفان إسكندر. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا.
إعتدال نمر عوض وزوجها وإبنها

إعتدال نمر عوض وزوجها وإبنها
إسـمي إعتـدال. أنـا أم َ إلبنتْيـن و أربعـةِ أبنـاء. تربيـة 6 أطفـال فـي بلـدٍ بحالـة حـرب لـم ُ تكـن بمهمـةٍ سـهلة، ولكنني كنت ً شـخصا متفائـ ًا ّ جدًا ُ . فكنـت وزوجي نحـاول أقصى ُج ِ هدنـا لجعـل ً حياتنـا حيـاة ّ هنيـة ولمنـح أوالدنا طفولـة سـعيدة. زوجي وليـد كان يملك ّ محـل ُ مفروشـات. أمـا أنـا فكنـت ُ أهتـم بأوالدِ نـا وكلمـا أتـاح لـي وقـت فـراغ كنـت ُّ أحب ُ أن أمضيـه بالتطريـز. كنـت ّ أتبـر َ ع بعملي لمركـز اإلنعاش لكي أسـاعد م ً ـن كان محتاجا.
إسـمي إعتـدال. أنـا أم َ إلبنتْيـن و أربعـةِ أبنـاء. تربيـة 6 أطفـال فـي بلـدٍ بحالـة حـرب لـم ُ تكـن بمهمـةٍ سـهلة، ولكنني كنت ً شـخصا متفائـ ًا ّ جدًا ُ . فكنـت وزوجي نحـاول أقصى ُج ِ هدنـا لجعـل ً حياتنـا حيـاة ّ هنيـة ولمنـح أوالدنا طفولـة سـعيدة. زوجي وليـد كان يملك ّ محـل ُ مفروشـات. أمـا أنـا فكنـت ُ أهتـم بأوالدِ نـا وكلمـا أتـاح لـي وقـت فـراغ كنـت ُّ أحب ُ أن أمضيـه بالتطريـز. كنـت ّ أتبـر َ ع بعملي لمركـز اإلنعاش لكي أسـاعد م ً ـن كان محتاجا.
منـذ ذلـك الحيـن، لـم ي َّمـر يـوم واحـد لـم أقضِ ـهِ فـي البحـثِ عنهمـا. منـذ ذلـك الحيـن ُ وأنـا لـم أسـتطع النـوم. كنـت َ أت َخّي ُ ـل كل السـيناريوهات المحتملـة، حتـى إنـي كنـت َ أسـمع محمـود ينادينـي لنجدتِ ـهِ .
بعد مرور شهر، وبينما كنت ً أحاول يائسة التواصل مع مختلف الميليشيات للحصول على أجوبة، أنا ً أيضا ُ خطفت.
ال أحـد يعلـم مـا الـذي حـد َث لنـا نحـن الثالثـة. أوالدي الخمسـة، دالل وفاطمـة وخالـد ِ ٍ كـوا وحدهـم. كان عليهـم أن يكبـروا بـدون أب ّ وال أم. كـم أتمنـى ُ وماهـر ووسـام، تر َ لـو اسـتطعت حماي ّ تهـم مـن الحـرب و تجنيبهـم كل هـذه المعانـاة.
إسمي إعتدال عوض، زوجي وليد وابني محمود. ال تدعوا قصتنا تنتهي هنا.
اسكندر زخريا

اسكندر زخريا
إسـمي اسـكندر. كانـت عائلتـي تناديني بإسـم ”اليكـو“. ف ُ قِ دت فـي 5 َّ ايار عـام 1985 ِ ُ ـع َ شـهادَة الماجسـتير فـي ُتاب ُ و كنـت ُ أبلـغ مـن العمـر 28 ُ سـنة. كنـت ً طالبـا ً طموحـا أ التســويق فــي الجامعــة األميركيــة في بيروت بينما ُ كنت ُ أعمل في بنــك ال HSBC. َبْي َ ـل ُ اختفائـي كنت قد ُ كان ح ُ لـم ُ حياتـي هـو إنشـاء شـركتي الخاصة. فـي الحقيقـة، وق ُ اشـتريت مسـاحتي الخاصـة لبدءِ هـذا المشـروع. ولكـن لـم تسـنح لـي الفرصـة لذلـك.
كنـت َ دائـم ِ اإلنشـغال، مـا بيـن الجامعـةِ والعمـل ُ ومسـؤولياتي فـي المنـزل. إذ ت ِّوفـي ِ ُ سـنواتٍ . وم ُنـذ َ ذلـك ُ الوقـت، كنـت َ المعيـل ُ أل ُ سـرتي. وفـي ع ِطـل َ والـدِ ي قبـل عشـر ُ نهايـةِ األ ُ سـبوع، كنت ّ أحب ّ أن أسـهر مـع رفاقي. وكانـت أختي الصغرى لينا تتوسـلني ِ باسـتمرار للذهـاب ً معـي. وأحيانـا كنـت آخذهـا معنـا حتى لـو لمجـرد جعلِ ها تبتسـم.
كنــت ّ مســتقرًا فــي منطقــة المصيطبــة؛ كانــت منطقــة تتمركــز فيهــا الكثيــر مــن الميليشـيات. فـي أحـد األيـام، أتـى رجـا ّ ن للتكل ُ ـمِ معـي عندمـا كنـت ِ فـي المنـزل مـع َ والدتـي وأختـي. طلبـت منهمـا أن يكل َ ماني في منزلـي و لكن َ هما هددا بـأن يأخذا عائلتي بأكملهـا إذا لـم أتعـاون وأذهـب معهمـا.
فذهبت ً معهما خوفا على حياة والدتي وأختي. ولم ُيَر ُ أو ي ْسمع ُ عني شيء منذ ذلك الحين.
تسـاءلت ّ لمـاذا أنـا؟ لمـاذا اتـوا إلـى منزلـي وأخذونـي؟ لـم أكـن متور ًطـا فـي السياسـة ً ولـم أكـن تابعـا ّ إلـى أيـة ميليشـيا. ربمـا السـبب هـو وظيفتـي فـي البنـك؟ فـي بحثهـا ِ مـن األشـخاص ّ الميئـووسِ منـه إليجـادي، اكتشـفت والدتـي أن ُ ـه قـد اختطِ ـف الكثيـر ً الذيـن يعملـون فـي القطـاع المصرفـي أيضـا.
إسمي اسكندر زخريا. ال تدعوا قصتي تنتهي هنا.
إدوارد صفير

إدوارد صفير
إسـمي إدوارد وكنـت أعمـل ِ فـي مجـال ُ البنـاء، وأعيـش فـي مسـقطِ رأسـي مـع أخـي َ منصـور وعائل ُ تـه. بالر ّ غـم مـن أن ُ نـي عشـت َ فتـرة ٍ حـرب ً ، كانـت حياتـي بسـيطة. لطالما ُ اعتبـرت ّ حظ ً ـي فـي الحيـاةِ نعمـة ُ مـن اللـه الـذي كنـت ّ ممتنًـا لـه.
أعربـت ُ عـن ذلـك االمتنـان بتكريـسِ وقتـي لكنيسـةِ ضيعتنـا، فقـد ترأسـت َ قاعـة وقـف ً كنيسـة مـار روكز في ريفـون. إضافة ُ إلـى أعمالي الخيرية، كنـت ً متفانيـا ُ لعملي وأردت ِ عملي فـي العقارات. ُ وكنت َ أهـوى الصيد َ اإلسـتثمار فـي المزيدِ من األراضي لتوسـيع ّ إلـى درجـةِ أن ُ ني كنت ّ أتشـوق إلى نهايـةِ األسـبوع للقيام برحـاتِ الصيدِ .
وفــي العــام 1985 ، َ تدهــور ّ الوضــع األمنــي َ فــي ريفــون. فأصبــح ِ مــن الصعــب علينــا ِ رحــا ِ تِ صيدِ نــا مــن الجبــال ّ التنق َ ــل داخــل ّ المنطقــةِ . أد َ ى ذلــك إلــى تغييــر مواقــع َ المجــاورةِ ، إلــى ســوريا. اســتمتعنا بالصيــد قــرب حلــب فــي ســوريا لمــرةٍ أو اثنتيــن. ُ ُ ختطِ فـت َ أنـا وصديقـاي. دفـع ذلـك اثنيـن مـن الصياديـن إلى ولكـن فـي المـرةِ الثالثـة، أ ِ ً ، وخصوصـا ِ ّ اختفائِ نـا. ال أسـتطيع تخيـل مـدى صعوبـةِ األمـر ِ عائلتـي علـى خبـر إطـاع ِ المأسـوي. ّ أنهمـا اضطـرا إلـى إعـا ْ مِ كلتـا عائلتـي فـؤاد وجـورج بالخبـر
لم نرجع بعدها إلى الوطن و الخبر الوحيد الذي تلقته عائالتنا بعدها هو خبر نقلنا من حلب إلى الرقة.
فــي ومضــة عيــن، انهــارت حيــاة أخــي. مــا إن اســتلم ّ الخبــر حت ّ ــى بــدأ بالبحــثِ عنــي ٍ ً تـاركا ّ وكـر َس ُ م ّ عظـم وقتـهِ لذلـك، حتـى إن ُـه َ انتقـل للعيـشِ في دمشـق تسـعة أشـهر ّ عملـه وموظ ُ فيـهِ وعائلتـه وراءه ُ . و لكـن جهـودُه ً لـم تكـن مثمـرة ُ إذ م َنِ ـع ِ من الدخـول إلى ً سـوريا مجـددا ممـا أجبـره علـى ايقـاف عمليـة البحـث
إســمي ادوارد صفيــر، وصديقــاي همــا فــؤاد حــداد وجــورج قــزي. ال تدعــوا قصتنــا َتنتهــي هنــا.
ابراهيم الكبش

ابراهيم الكبش
اسمي ابراهيم الكبش. هذا الإسم يظهر في سجلات جميع مراكز الشرطة في صيدا.
"ابراهيم الكبش، فُقد في 4 تشرين الأول من عام 1984"
بعد عدة محاولات لإيجادي، رأى والدي بأن هذا هو ملاذه الأخير وإعتقد ودون أن ترتفع آماله كثيراً، أن يطلب من جميع مراكز الشرطة التحقيق في مصيري وأن هذا سيزيد فرص العثور عليّ. وبعد مرور ستة عشر عاماً فقط على تسجيل ولادتي، قدِم والدي نحو السلطات مجدداً وذلك لتسجيل اسمي بينما كان الألم يتملك قلبه.
قال لهم الذي كان يعرفه، رغم قلتها: أخبرهم بأنني كنتُ أُساعده في عمله – إذ كان والدي يعمل كطباخاً في كفتيريا في مستشفى حمود في صيدا – وإنني أردتُ أن أدرس الفندقية بسبب تأثير والدي وعمله عليّ. في اليوم الذي فُقدتُ به، ذهبتُ الى المستشفي لإيقاف دراجتي التي كُنتُ إشتريتها مؤخراً وذهبتُ لإمضاء الوقت مع أصدقائي على الكورنيش. ومنذ ذلك اليوم، لم يسمع والدي أي نبأ عني.
كانت تلك القصة هي القصة التي كان يرددها والدي عشرات المرات لضباط الشرطة، رغم أنه كان على علم بأنهم لا يستطيعوا مساعدته وبأنهم كانوا يستمعون اليه دون إتقان أو تبصر.
مرّت أيام وأشهر عدة والمعلومة الوحيدة التي وصلت عائلتي هي أنه قد وقع إنفجار في اليوم الذي فُقدتُ فيه. وينبغي أن تكون تلك المعلومة دون ذكر أي تفاصيل أُخرى، تفسيراً لما حدث لي. وفي أعين الناس، كُنتُ قد توفيتُ ووجب على عائلتي الحداد عليّ وعدم السؤال عن مصيري.
ولكن بعد مرور إثنان وثلاثون عاماً، بغضّ النظر عن الوقت الذي كان قد مرّ، ما زال الشكّ يراود عائلتي حول مصير فقداني ولا زال ألم فقداني عميق في عائلتي.
اسمي ابراهيم الكبش. قصتي لا تنتهي هنا.
Why are we still looking for the disappeared?
Iteractive digital space designed to bring to the public some of the individual stories of the thousands of persons who went missing in Lebanon over the past four decades, and whose families continue to struggle to learn their fate.